التّقويم يهدف إلى تشخيص مكتسبات التّلاميذ، ومستوى تحصيلهم المعرفي والمهاري، تعرف درجة تحكّمهم في المكتسبات والخبرات والّتعلّمات، إضافة إلى تصحيح مسار التعلم بتجاوز نقاط الضّعف ،كما أنّه يساعد المدرّس على الحكم على مدى كفاية استراتيجيات التّدريس وطرقه وأساليبه التي يمارسها، وتصنيف التّلاميذ حسب قدراتهم ومستوياتهم المعرفية، وميولهم واستعدادهم، ومن ثَمَّ اتخاذه للقرارات الملائمة لأجل تحسين عمليّة التّدريس، إنّه عملية تمكِّن من التّعرّف على مستوى تحقّق الأهداف المسّطرة، والغايات المحدّدة، وهو ما يهدف إليه نموذج تايلور.
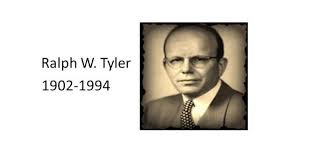
- Enseignant: adaa medjeded
تتبوأ اللّغة في الخطاب الأدبي
عموما والشّعري خصوصا، مكانة متميزة بين سائر مكوّناته البنيوية، إذ أنّها مادة
الأديب بما توفّره له من مفردات وتراكيب تمكنّه من التعبير عن هواجسه ومشاعره.
والمعجم الشعري أو البنية المعجمية للقصيدة هي مجموعة من المونيمات التي تحمل دلالات خاصة بمفردها أو في سياقها التركيبي.
ويتفرع المعجم الشعري للقصيدة الجزائرية المعاصرة على حسب الدكتور يوسف وغليسي إلى قسمين:
1- معجم وجداني:
هو معجم غنائي ذاتي يسعى إلى تذويت الموضوع، ويسِمُهُ بسمات وجدانية واضحة تقوم على دوال لفظية رقيقة وناعمة، تنفذ إلى الوجدان بصورة حسية بحكم قربها من ذاته ومعايشته الذاتية لها، ويتكئ هذا المعجم على المونيمات (المفردات) التالية: الحبّ، الشوق، الفراق، الذكريات، الماضي، الحلم، الفؤاد، الغربة، العذاب، الحنين.... بالإضافة إلى مونيمات أخرى مستمّدة من الطبيعة ذات وقع خاص على الوجدان: البحر، الموج، الشاطئ، الشراع، الشّمس، الغيم، الليل، النّهر.
وقد ساد المعجم الوجداني في الخطاب الشعري الجزائري خلال الثمانينات بصورة لافتة، بعد غياب نسبي خلال السبعينات تحت وطأة الواقعية الاشتراكية التي لا تسمح للشاعر بالانسياب المطلق في مجاريه الشعرية الداخلية.
وعلى عكس ذلك عمّ المعجم الوجداني معظم الأشعار المكتوبة خلال الثمانينات، حتّى عند أشهر الملتزمين ( عيسى لحيلح، عز الدين ميهوبي مثلا) بحكم جملة من العوامل نذكر منها:
أ- زوال عامل الالتزام الاشتراكي، وعدم إلتزام الخطاب الشعري الثمانيني بقضية واضحة محدّدة يدافع عنها.
ب- أخذ العبرة من سلبيات المرحلة السابقة، التي حاولت أن تُموضع الذّات الشّعرية وأن تتشّبث بالقضايا الموضوعية الخالصة، فكانت النتيجة ضياع الهوّيات الشخصية للشعراء في غمرة الجري وراء تلك القضايا.
ج- العودة الواضحة إلى التراث الشعري القديم، التي شهدتها مرحلة الثمانينات وكان – لابدّ – أن تصطبغ هذه العودة بالصبغة الوجدانية المنعكسة على المعجم الشعري، بحكم أن الخطاب الشعري العربي القديم قد لازمته صفة "الغنائية/الذاتية".
2- معجم واقعي :
هو معجم موضوعي يستهدف "موضعة الذات" والابتعاد عن حدودها الضيّقة بالولوج في عوالم الواقع الفسيحة والتقاط جزيئاتها وعكسها على المساحة المعجمية للخطاب الشّعري.
ساد هذا المعجم بوضوح خلال السبعينات، حيث تجلّت معالم الواقعية الاشتراكية التي تسعى إلى التقاط الهموم اليومية للطّبقة الكادحة، وتعكسها على هذا الحقل المعجمي: الفلاح، المعول، السنبلة، الفقر، الجوع، الحصاد، الرغيف، العرق، المناجل..... بالإضافة إلى أسماء بعض أعلام الاشتراكية والرموز الثورية : "نيرودا" و"لنين" و"لوركا".....
وقد ساد في الثمانينات في صورة جديدة يمكن تسميتها الواقعية الإسلامية التي كانت قد ظهرت ملامحها في قصائد "محمد ناصر" و"مصطفى الغماري"، لتتبلور – فيما بعد – لدى "عيسى لحيلح، حسين زيدان، محمود حمودة نور الدين درويش، ناصر لوحيشي.....
تجسّدها ألفاظ: الجهاد، الخضراء، الصلاة، القرآن، السيف، أفغان.... مسايرة لملاح الصحوة الإسلامية التي بدأت في البروز مع مطلع الثمانينات.
وينضوي تحت المعجم الواقعي أيضا معجم آخر هو المعجم الثوري الذي يخيط النسيج الدلالي المكوّن له من الألفاظ التالية: الخيل، السيف، المطر، اللّهب، البركان، الرّيح، العاصفة، الدم، الثورة، الطوفان، الموج، الصّراخ....
الفئة المستهدفة: السنة اولى ماستر أدب جزائري.
- معرفة جذور الشعر الجزائري المعاصر.
- إدراك الطالب لأعلام الشعر الجزائري المعاصر.
- تصنيف على موضوعات الشعر الجزائري المعاصر
- تطبيق الخصائص الفنية للقصيدة الجزائرية المعاصرة على نماذج شعرية مختارة.
- تحليل معجم القصيدة الجزائرية المعاصرة.
- تقييم الطالب لوظيفة الشاعر الجزائري المعاصر من منظور نقدي معرفي وما الذي أدخله على المدونة الشعرية الجزائرية المعاصرة من خلال شكل القصيدة ومعجمها الشعري حسب الذهنية المنتجة له، بناء على المصادر والمراجع وآليات التحليل المتاحة للطالب.
- التقييم بواسطة امتحان كتابي حضوري في آخر السداسي، يحتوي على كل ما تّم التطرق إليه ومناقشته في المحاضرة بالإضافة إلى تمارين من الأعمال الموجهة، ويدخل في النقطة بنسبة 60 %
- التقويم المستمر والذي يكون في حصة الأعمال الموجهة، يدخل في النقطة النهائية بنسبة 40 %، مقسم إلى 30 % امتحان قصير، بعد كل فصل، و 10 % الحضور والمشاركة في كل حصة، حيث يكون معدل النجاح يساوي أو يفوق 10/20.
لكي يستطيع الطالب استيعاب كل المفاهيم التي يتم التطرق إليها أثناء المحاضرة والقدرة على القيام بكل أنشطة التعلم، أنتظر منكم:
أ- الحضور المستمر للمحاضرة.
ب- تدوين كل المعلومات وأخذ رؤوس أقلام لكل ما تمّ مناقشته.
ج- المشاركة في كل المناقشات، وطرح كل الأسئلة التي لم تتوصلوا إلى الإجابة عنها.
د- تبادل الآراء ووجهات النظر حول المواضيع المطروحة لإثراء المكتسبات والمعلومات في حصة الأعمال الموجهة.
هـ - يتم التحقق من القدرة على توظيف المعلومات المكتسبة في المحاضرة لحلّ التمارين.
تعتمد المهارات المستهدفة على ثلاثة ركائز وهي:
1- المعرفة.
2- الخبرة المكتسبة من المعرفة.
3- توظيف المعرفة.
وتعتبر هذه الكفاءات مهمة في عملية التعلّم، وتحتاج إلى منهجية لتكون قادرة على تحقيقها، كما ستدعم بتقويمات لاختبار قدرة الطالب على استيعاب المعلومات المقدمة وتحقيق الأهداف المرجوة.
أ- بالنسبة إلى المعرفة:
في هذه المحاضرة سيكتسب الطالب قدرة على التعرف والتعلّم، وفهم آليات تحليل نص شعري جزائري معاصر، وتكتسب هذه الكفاءة عن طريق تخزين المعلومات والمفاهيم الخاصة بالدرس وتدّعم هذه الكفاءة عن طريق تمارين وأسئلة نظرية حول مدى فهم واستيعاب هذه المعلومات.
ب- بالنسبة إلى الخبرة المكتسبة من المعرفة:
وهي كيفية تطبيق هذه المعلومات والمفاهيم والمعارف حول النص الشّعري الجزائري المعاصر وتدعم هذه الكفاءة ببعض التمارين المتنوعة التي تزيد من استيعاب الدرس وإثراء المفاهيم المقدمة.
ج- بالنسبة إلى توظيف المعرفة:
وهي تتمثل في تطبيق المفاهيم المكتسبة على أرض الواقع أي في المجالات المختلفة للنص الشّعري الجزائري المعاصر.
مقياس النص الشعري الجزائري المعاصر مقسم إلى: حصة محاضرة وحصة أعمال موجهة.
ففي المحاضرة يتّم التعّرف واكتساب المعارف والمفاهيم اللازمة النظرية لتوظيفها وتطبيقها في حصة الأعمال الموّجهة.
على الطالب الإطلاع على كل المراجع التي وضعت تحت تصرفه، وذلك لضمان السيرورة الجيّدة لاكتساب كل الكفاءات المستهدفة، ومن ثمّ النجاح المؤكد.
على الطالب أن ينظر على المراجع الآتية:
1- عبد الملك مرتاض: معجم الشعراء الجزائريين في القرن العشرين، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر.
2- عبد الحميد هيمة: البنيات الأسلوبية في الشعر الجزائري المعاصر، شعر الشباب نموذجا، مطبعة هومة، الجزائر، ط 1، 1998م.
3- يوسف وغليسي: في ظلال النصوص – تأملات نقدية في كتابات جزائرية، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، ط 2، 1433 هـ/2012م.
4- يوسف وغليسي: لغة الشعر الجزائري المعاصر (1970-1990)، جسور للنشر والتوزيع الجزائر، ط 1، 1438 هـ/2017م.
5- يوسف وغليسي: دراسة في الشعر النسوي الجزائري، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، ط 1 1434 هـ/2013م.
ينظر أيضا:
أ- الدكتور يوسف بكوش: محاضرات في مقياس النص الشعري الجزائري المعاصر المدرجة على منصة مودل- جامعة احمد زبانة بغليزان.
http://elearning-ar.univ-relizane.dz/moodle/course/index.php?categoryid=5
ب- قناة الدكتور يوسف بكوش على اليوتوب (بها شروحات لدروس النص الشعري الجزائري المعاصر) youcef bekkouche/youtube.com (قناة الدكتور يوسف بكوش).

- Enseignant: Youcef BEKKOUCHE
لسانيات النّص هو العلم الذي يُطلق عليه علم اللسانيات أو علم اللغة أو علم اللغويات، وهو العلم الذي يولي اهتمامًا كبيرًا بدراسة لغات البشر جميعًا فيما يتعلق بنواحيها كافةً من تراكيب وخصائص، بالإضافة إلى ما بينها من نقاط تشابُه أو نقاط اختلاف، حيث يقوم هذا العلم بدراسة اللغات من جميع جوانبها دراسة وافية وشاملة، ويُطلق على الشخص الذي يقوم بتلك الدراسات لقبُ اللغوي.
وقد ظهر علم اللسانيات الحديث في القرن التاسع عشر على يد عالم اللغويات السويسري فرديناند دي سوسير، فقد كانت فكرته علمنة اللغة كما حدث مع الثورة الصناعية، إذ تحمل عنده اللغة هويات مختلفة من الدين وقيمه ومن المجتمع المحيط والفكر الفلسفي والثقافة السائدة. ويُطرح مفهوم لسانيات النص الإشكاليات التي تعتري العلاقة بين الدال والمدلول أو الدلالة وهي المعنى، ولم تقتصر لسانيات النص على تسليط الضوء على العلاقة بين المسميات والأسماء ولا على العلاقة بين المفاهيم والتصورات، وإنَّما حاولت أن تُشرِكَ الوعي الإبداعي في إثراء تلك العلاقات العديدة، خصوصًا أنَّ علاقة النص الإبداعي بالمدلول الخارجي الخاص به تعدُّ نموذجًا مبسطًا للعلاقة التي تربط اللغة بالعالم.
وتقوم لسانيات النص منذ أن ولدَت على يد دي سوسير بمحاولات لتحليل مكونات اللغة، وتقديم نماذج من أجل تحليل النص الأدبي والخطابات وعناصرها، كما وردَ لدى كل من تشومسكي وهاريس وبنفينست، من تناولهم التحليلية لمستويات القول ابتداءً من أصغر وحدة في الكلام وصولًا إلى أكبر وحدة، وذلك من خلال اعتمادهم على الإجراءات اللسانية الوصفية بغية اكتشاف بنية النص، وبالتالي الاعتماد على دراسة علاقات الجُمل التوزيعية هذا من جهة، ومن جهة أخرى العمل على ربط اللغة بسياق الموقف الاجتماعي، لكنَّ كل ذلك تحول لاحقًا إلى دراسة لسانيات النص، التي اهتمت بنحو النص أيضًا، حيث يتخذ لسانيات النص من النص المحور الأساسي للتحليل اللساني، فيبدأ من النص وينتهي به، وله العديد من المصطلحات التي يقوم عليها عندما يعمل على أداء النماذج التحليلية، ومن خلالها يستمدُّ كثير من العلاقات النصية والأسلوبية.
الفئة المستهدفة: السنة الثالثة ليسانس تخصص: لسانيات عامة.
أهداف الدرس:
عند الانتهاء من هذا المحور، سيكون الطالب ملمّا بأهداف المحور بناء على مستويات بلوم المعرفيّة:
مستوى المعرفة والتّذكر (المكتسبات القبلية) : يسترجع الطالب المعلومات القبليّة المتعلّقة بالمفاهيم والمصطلحات المرتبطة بالجملة والكلام.
مستوى الاستيعاب: يتوصّل الطلبة إلى تحديد المفاهيم المدروسة في المنجز اللّساني واستعمالها بوعي في تطبيقاتهم.
مستوى التّطبيق: يطبّق الطالب على فقرة ويجدول كلّا من الجملة والكلام، ويدرس الإسهامات التطبيقية المعتمدة في المنجز التراثي اللساني النّصي العربي والغربي.
مستوى التّحليل: يميّز الطالب بين المحطات الثلاثة الكبرى التي أسهمت في إخصاب أرضية التّحول من لسانيات الجملة إلى لسانيات النّص.
مستوى التركيب: يفحص الطالب البدايات التّأسيسيّة لنشأة لسانيات النّص.
مستوى التقويم: يقارن الطالب بين أدوات الاتساق وأدوات الانسجام.

