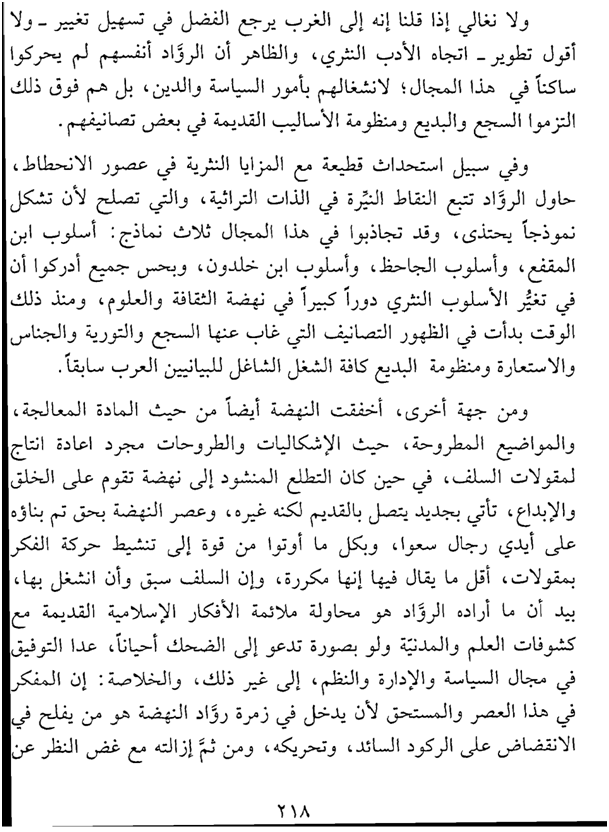المحاضرة الخامسة
المقال الصحفي
تعد الآداب أعرق مظاهر النشاط الإنساني لدى الشعوب، ومنها العرب الذي امتازوا - منذ القدم - بشغفهم الشديد بفنون القول فبرزوا في الشعر خاصة فكان ديوانهم ووسيلة إعلامهم حتى كانت من بين معجزات قرآنهم أدبية لغويّة، وقد تنافسوا في فنّ القول فنظموا القصيد وأرجزوا ، ونثروا الخطب والوصايا ، وأوجزوا الأمثال والأحاديث. غير أن تطوّر الفنون أظهر أجناسا أخرى لم يعرفوها هم منها فن المقال الصحفي.
ولا شكّ أنّ تطوّر تاريخ فن الكتابة في الأمم لها مستويات مختلفة؛ أدبيّة وعلميّة ثمّ صحفيّة تقوم الأولى على الذاتيّة والثانيّة على الموضوعيّة والثالثة على العمليّة وهي لغة المقالات الصحفيّة.
نشأة المقال وتطوره
للمقال علاقة بالصحافة، وإنّ نجاح أيّ صحيفة إنّما هو مرتبط بعدد المقالات التي تنشرها، بمعنى أنّ قيمة الصحيفة تكمن في أقلامها التي تكتب فيها تتباهى بمقالاتها، تفتخر بكتّابها، وتعمل على تدعيم مركزها ورواجها في سوق القراء بما عندها من كتّاب يرفعون لواءها. ولطالما كان لها دور كبير في مجال التوجيه وتكوين الرأي العام والإرشاد والتنوير، من خلال ما تنشره خدمةً لقرّائها[1].
ظلّ المقال هو المميّز للصحافة منذ نشأتها في القرن السادس عشر على يد الفرنسي (ميشيل دي مونتين Michel de Montaigne) إلى الحرب العالميّة الأولى حيث تراجع المقال إلى الصفحات الداخلية للصحف بعدما كان يتصدّر صفحاتها الأولى، ومع نشوء الحرب تصدّر الخبر صفحاتها الأولى.
أطلق (مونتين) على مقالاته اسم (المحاولة) Essai وكأنّه يعتذر أن يكتب موضوعا واحدا أو يتعمّق فيه، والمحاولة في اصطلاح الفنّانين هي معالجة صنع التمثال من مادة رخوة كالشمع وهذا قبل إفراغه في قوالب نحاسيّة أو نحته من الرخام، ولذلك أراد (مونتين) أن تكون محاولاته رخوة بقصرها على الأحاديث المستخفّة والتجارب الشخصيّة التي يتسامر بها الأصدقاء والإخوان تزجيّة للوقت والفراغ. فكان القرن ال16 ميلاد المقالات الصحفيّة ولأنّها البداية كان لا بدّ أن تكون بهذا الشكل، وفيها ينهل الكتّاب من تجربتهم الذاتية في تناول الموضوعات التربوية والخلقية التي انصرفوا إلى معالجتها، ولقيت مقالاتهم رواجا في أوساط القراء.
وفي القرن 17 ظهر (فرنسيس بيكون Francis Bacon) الذي استفاد من (مونتين ) فطوّر تجربته في ضوء أعماله وتخلّص من الذاتيّة واقترب أكثر الموضوعية فكان أشدّ وضوحا في مقالاته، مع ميله إلى الموضوعات الخلقية والاجتماعية المركزة. فكانت مقالاته أقرب إلى التركيز والإدماج منها إلى التبسيط والفكاهة. وبعد الانتشار الواسع للصحافة التي لم تعد تستغني عن المقالات كنوع من أنواع الكتابة الوجيزة لقيت مقالات (بيكون) رواجا كبيرا.
وفي القرن ال 18 ظهرت المقالة كنوع أدبيّ قائم بذاته، يتناول فيه الكتّاب مظاهر الحياة في مجتمعهم بالنقد والتحليل وقد أعان تطوّر الصحافة على تطوير هذا العنصر الأدبي، وبرز فيه عنصر جديد وهو عنصر السخرية والفكاهة، وإن كانت الرغبة في الإصلاح هي الغاية الأساسية لهذا الفن الجديد.
واتسع نطاق المقالة في القرن ال19 لتشمل نواحي الحياة كلّها، وازدادت انطلاقا وتحررا واتّسع حجمها بحكم ظهور المجلات المتخصصة.
تعريف المقال
وكلمة (مقال) عند الانجليز تعني (المحاولة) وهذا يعني أنّها غير مكتملة؛ فهي عبارة عن خواطر متناثرة ومجرّد مذكرات تمتاز بالخصوصيّة ، وعلى قارئها أن يقوم بإكمال ما نقص فيها.
للمقال تعريفات كثيرة منها:
أولا: التعريف الغربي
- تعريف معجم لا روس: "اسم يطلق على الكتابات التي لا يدّعي أصحابها التعمّق في بحثها، أو الإحاطة التامّة في معالجتها، ذلك أنّ كلمة (مقال) تعني محاولة أو خبرة أو تطبيقا مبدئيّا أو تجربة أوّليّة"[2]
- تعريف معجم أكسفورد: "إنشاء كتابيّ معتدل الطول في موضوع ما، وهو دائما يعوزه الصقل ومن هنا يبدو أحيانا أنّه غير مفهوم ولا منظّم"[3]
- دائرة المعارف البريطانية:
هو إنشاء متوسط الطول. يكتب للنشر في الصحف ويعالج موضوعا معينا بطريقة مبسطة وموجزة على أن يلتزم الكاتب حدود الموضوع.
- تعريف الدكتور (جونسون : هو "وثيقة عقلية لا ينبغي أن يكون لها ضابط من نظام، وهو قطعة إنشائيّة لا تجري على نسق معلوم، ولم يتمّ هضمها في نفس صاحبها، أمّا الإنشاء المنظم فليس من المقال في شيء"[4] وله تعريف آخر مفاده أنّ المقال "هو الإنشاء المتوسّط الطول يكتب نثرا عادة ويعالج موضوعا بعينه بطريقة بسيطة موجزة على أن يلتز الكاتب حدود هذا الموضوع، ويكتب عنه من وجهة نظره"[5]
وقد تعرف المقالة على أنّها تعبير عن إحساس شخصيّ، أو أثر في النفس ، أحدثه شيء غريب، أو جميل أو مثير للاهتمام، أو شائق أو يبعث الفكاهة والتسلية. وهذا يعني أنّ كاتبها يعبّر عن الحياة، وينقدها بأسلوبه الخاص، فهو يراقب ويسجّل ويفسّر الأشياء كما تحلو له.[6]
فهذه التعاريف لا تعارض بينهما فهي تتفق على أنّ المقال وجهة نظر صاحبها تجاه موضوع ما في المجتمع، موقف خاص يتّخذ من قضيّة ما، وغالبا ما يحتاج إلى صقل لأنّه يكتب في وقت قصير، يلتزم فيه الإيجاز ولذلك فهو معتدل الطول، طرحه قد يكون ذاتيّا أو موضوعيّا يعود إلى شخصيّة صاحبه.
ثانيّا: التعريف العربيّ:
- الدكتور محمد يوسف نجم:
المقالة قطعة نثرية محدودة الطول والموضوع، تكتب بطريقة عفوية سريعة ،خالية من التكلف، وشرطها الأول أن تكون تعبيرا صادقا عن شخصية الكاتب.
- الدكتور محمد عوض: تشعرك المقالة الأدبية وأنت تطالعها أن الكاتب جالس معك، يتحدث إليك.. وأنه ماثل أمامك في كل فكرة وكل عبارة.
- الدكتور محمود أدهم فكرة يستغلّها الكاتب الصحفي خلال معايشته الكاملة للآراء والقضايا والأنباء والمواقف والمشكلات والاتجاهات المؤثرة في القراء وفي حركة المجتمع، يقوم بعرضها وشرحها ومعارضتها أو تأييدها في لغة واضحة وأسلوب يعكس شخصيته وفكره، وتنشر في الوقت المناسب وفي حجم يتلاءم مع نوعيتها وأهميتها ونتائجها المستهدفة.
وهناك تعريفات أخرى لآخرين منها:
- إنه اسم يطلق على الكتابات التي لا يدعي أصحابها التعمق في بحثها أو الإحاطة التامة في معالجتها.
- إنه فكرة يأخذ بها الصحفي ليعالجها بأسلوبه الخاص وطابعه المتميز، ويشكل دعوة للقراء للتفكير والتدبر وربما التصرّف تجاه الأحداث من واقع فهمه لها.
- هو الذي تنشره الصحيفة لتغطية اهتمامات أو تساؤلات ذات صفة حالية مرتبطة بالأحداث أو المشكلات أو القضايا الهامة بالفعل للجمهور أو تلك التي يمكن أن تحدث في حياتهم في المستقبل القريب وهذا المقال يمتاز ببلاغته الصحفية ويتخذ الصيغة المميزة لطابع الصحيفة أو صيغة المدرسة أو المذهب الصحفي الذي ينتمي إليه الكاتب.
هذه التعاريف على كثرتها تتفق ولا تتعارض في تعريفها للمقال، وأهم ما يميّزها أنّ صاحبها متأثر بشيء ما يفرغ تأثّره في مقال يكون صادقا فيه مع نفسه وبلغة سهلة يفهمها القراء على اختلاف مشاربهم. وهي وجهة نظر صاحبها حول موضوع ما يشغل الرأي العام، قد يكون فيه ذاتيّا فتبرز ملامح صاحبه وشخصيّته تجاه موقف عاشه. وقد يكون موضوعيّا يبرز في المقال الجانب الموضوعي من خلال تناوله لفكرة في المجتمع أو مشكلة في الواقع المعيش.
يرتبط المقال الصحفي بالإعلام الذي يحتوي على ثلاثة أنواع رئيسيّة هي:
- الإعلام أي إعلام المواطن بجملة من الأخبار التي حدثت في المجتمع أو خارجه.
- الدعوة المقصودة: مثل المقال الافتتاحي، والكاريكاتير، والمقال التفسيري الذي يجعل القارئ يصل إلى استنتاج معيّن.
- المضمون: وهو ما يراد به الترفيه أو الإعلام بحيث يكون الإقناع منتجا فرعيا محتملا.
وظائف المقال الصحفي
- الاعلام: يقدم المقال الصحفيّ المعلومة للقارئ وجعلها متاحة للجميع باعتماد لغة سهلة يفهمها القارئ.
- الشرح والتفسير: حيث يتمّ شرح الأحداث وتفسيرها سواء أكانت على المستوى المحلي الوطني أم الدولي العالمي.
- التعبئة الجماهيرية: من خلال نشر الوعي بين صفوف الشعب وطبقات المجتمع المختلفة.
- الدعاية السياسية: وذلك بعرض الأوضاع السياسية لمجتمع ما وتقوية همزة الوصل بين السلطة والرعيّة .
- التثقيف: وذلك بزيادة الكم المعرفي من مختلف العلوم والمعارف، ونشرها على أوسع نطاق. إضافة إلى رصد كل التطورات والمستجدات على جميع المستويات والتخصصات.
- الدفاع عن القيم والمبادئ السامية والتمتّع بالحريات لأجل الاختلاف والمعارضة، فالاختلاف في المجتمعات المتقدّمة شيء أساسي بل حتميّ ولا يعني أبدا الصراع.
خصائص كتابة المقال
- القِصر : يجب أن لا يتجاوز الصفحة وإلا صار فنا آخر من فنون الكتابة .
- النثر : شكل المقال هو النثر ولا يمكن كتابته إلا نثرا وإلا صار نوعا آخر .
- التصميم : هو بناء وشكل المقال. يبدأ بمقدمة تعرض فكرة المقال وتعرفها في سطور لننتقل إلى صلب المقال الذي يعرض كل تفاصيل الفكرة ويحيط بجوانبها . لنخلص إلى نتيجة واضحة وصريحة نعرضها في خاتمة المقال .
- الذاتية : هي لمسة وبصمة الكاتب التي تميز مقاله ويتم التعرف على هذا من خلال كلمات دالة على الفرح أو الغضب أو الفخر …
- الموضوع : هو فكرة المقال التي يطرحها ويحاول معالجتها وايجاد حلول لها ويتطلب هذا معرفة واسعة وتجارب حية تخدم وتساعد الكاتب في طرح فكرته .
- الأسلوب : أسلوب المقال وموضوعه حامل ومحمول . لذا لا بد أن يتوافقا ويقصد بذلك الطريقة التي يعبر بها الكاتب عن فكرته ويوصلها للقارئ بكل وضوح داعماً ذلك بوسائل الإقناع و التشويق.
[1] ينظر محمود اللحام، ماهر الشمايلة، مصطفى كافي، مدخل إلى علم الصحافة (الطبعة الأولى)، الأردن: دار الإعصار العلمي للنشر والتوزيع،
[2] عبد اللطيف حمزة، المدخل إلى فنّ التحرير الصحفي ، دار الفكر العربي، ط4 /د ت، ص 230
[3] م ن، ص 231
[4] عبد العزيز شرف، الأساليب الفني|ة في التحرير الصحفي، ، دار قباء للطباعة والنشر والتويع - القاهرة،2000، ص 333.
[5] م ن، ص ن.
[6] سوسن رجب، فــن المقـالة، موقع https://lahodod.blogspot.com
المحاضرة الرابعة
دراسة فنّ القصة
الفنّ القصصي فنّ نثريّ، وهو فنّ قديم عرفته الشعوب على اختلاف حضاراتها غير أنّ بدياته كانت بسيطة وتطوّر مع الزمن. بدأ مرتبطا بالغيبيّات والموضوعات التي أساسها الخيال المحض مثلما نجد في الأساطير اليونانيّة وما بعدها.
يقوم الفنّ القصصيّ على الحدث والوصف – ليس وصف الأشياء ولكن وصف الحياة والأشخاص ومجال الأحداث- كما يقوم على الصراع النفسي بين الشخصيّات من خلال الخير والشر. ومن خلاله تتمّ معالجة الحاضر وحتى إذا اتكأ على الماضي فإنّما لأهمّيته في الحاضر أي الماضي الذي ينير الحاضر ويدفع به إلى المستقبل.
نشأة الفن القصصي وتطوّره
ولا شكّ أن الفنّ القصصيّ مرّ بمراحل حتى وصل إلى ما هو عليه الآن حيث نجد العنصر القصصي بارزا في الملاحم اليونانيّة إذ ربط هوميروس "داعيّة الألم بالمخاطرات التي قامت به الشخصيّات في الأوديسة. وقد مهّد كذلك للقصص الخياليّة النثريّة ما قام به شعراء المآسي اليونانيّة منذ (يوربيدس) من ربطهم العنصر العاطفي بالأحداث التي يسوقونها غيبيّة كانت أم إنسانيّة"[1] كما نجد بشائرها أيضا في الأدب اليوناني في أشعار الرعاة وكذا حكايات عن الرحالة الاسكندر المقدوني. ومن القصص اليونانيّة نجد قصّتي (ثيارجينس Theargenes) و (خاركليا Chariklea) أو ما عرفا بـ أسيري الأحباش Aethiopica من تأليف هيليودور Heliodore الفينيقي في القرن الثالث الميلادي • التي أثرت بشكل كبير في الآداب حتى العصر الكلاسيكي. كذا قصة دافنس وخلويه Daphnis et Chloe من تأليف لزنجوس Longus أيضا في القرن الثالث.
وظهرت القصّة في العصر الروماني في القرن الأول الميلادي مخالفة في بدايتها لليونانيين، كما نجد في قصة ساتيريكون Satiricon لصاحبها بيترنيوس Pétrone. ثمّ سرعان ما تأثرت بالقصص اليونانيّة كقصة أبوليوس أو الحمار الذهبي والملاحظ هنا أنّ القصّة ظلّت مرتبطة بأصلها الملحمي ذات الأحداث العجيبة غير المألوفة القائمة على الأمور الغيبيّة.
بدأ عصر النهضة وما بعده متأثرا بما سبقه من قصص ممتزجا بروح مسيحيّة، فظهرت قصص المخاطرات من أساطير وتوظيف الجنّيات وخوارق العادات كما نجد في أسطورة فاوست ولكن سرعان ما بدأت النزعة الانسانية تظهر من خلال قصص الفروسيّة وقصص الرعاة؛ حيث نجد قصّة أماديس دي جولا Amadis de Gaula الإسبانيّة لصاحبها جارثيا رودريجاز Garcia Rodriguez التي أثرت في قصص الفروسيّة في اوروبا. ثمّ جاءت قصة سجن الحب لسان بيدرو San pedro سنة 1492م ثمّ ديكاميرون Decameron لـ بوكاشيو الإيطالي حيث تحتوي على 1355 قصّة ثمّ يأتي سيرفانتيس في أدب الفروسيّة التي يسخر منها لما فيها من تصنّع وزيف من خلال (دون كيشوت) التي قلّد فيها قصص الفروسيّة تقليدا ساخرا ونقل الحوادث من الناحيّة المثالية التي تشير إلى المأساة إلى ناحيّة هزليّة يتصادم فيها المثال بالواقع الأليم. كما نجد في إسبانيا روايات الشطار وهي قصص تتحدّث عن العادات و التقاليد للطبقات الدنيا في المجتمع وتسمى القصّة البيكاريسكيّة Picaresca تشبه إلى حدّما المقامة في الأدب العربي.
ازدهرت الفنون القصصية في فرنسا الكلاسيكيّة وأثرت "القواعد العقليّة في المسرح فعني فيه بالتحليل النفسي وخاصّة التحليل العاطفي" وبخاصة في مسرحيّات (راسين) وانتقل هذا الشعور إلى القصة ودعا النقاد إلى أن تكون حوادث القصة ممكنة ومحتملة في سياقها، لتتجرّد من آثار ما فوق الطبيعة ودعوا إلى التقليل من طابع القصّة الشعري
حتى القرن 18 كان الاعتناء بالطبقات الاجتماعيّة وحاجاتها وهو ما نسمّيه بالنوع الإنساني، ثمّ ازدهرت بعد ذلك اتجاهات حديثة أخرى في أواخر هذا القرن حيث تحوّل الاعتناء بالفرد ونزعاته ومثله، ليكون هو وحدة الإصلاح في المجتمع وإنصافه من طغيان المجتمع وقيوده الظالمة في القصص الرومانتيكيّة. كما نرى في البائسين les misérables لفيكتور هيجو Victor Hugo لتظهر القصة ذات القضايا الاجتماعيّة باتجاهين يلتقيان في النهاية هما الفرد وحقوقه المهضومة، والتعاون الاجتماعي بين الأفراد ذات الحقوق المهضومة. وفي ظل الرومانتيكيّة نشأ جنس القصّة التاريخية لإحياء الماضي الوطني على يد ولتر سكوت Walter-Scott الذي كان يختار موضوعاته من العصور السحيقة من دون أن يجعل الشخصيّات تحل المكانة الأولى ولكنّه يجعلها في المرتبة الثانيّة ويضع مكانها شخصيات أخرى غير تاريخيّة تمثّل روح العصر الذي يكتب عنه، حتى لا تمنعه من التصرّف القصصي وتحرمه من التجربة الفنيّة، ويستطيع أن يبعث من جديد صورة ذلك العصر بخصائصه الزمانيّة والمكانيّة. وبعد الرومانتيكيّة استكملت القصة خصائصها الفنيّة مع المذاهب التي تلت الرومانسية كالواقعيّة والرمزيّة وغيرهما.
أمّا القصّة في الأب العربي "فلم يكن لها شأن يذكر وكان لها مفهوم خاص لم ينهض بها ولم يجعلها ذات رسالة اجتماعيّة أو إنسانيّة"[2] ذلك أنّها لم تكن في جوهر الأدب كالشعر والخطابة والرسائل حيث تخلى عنها كبار الأدباء لغيرهم من كتاب السير والوعاظ.
وهذا لا يعني أنّهم لم تكن لهم قصصهم التي يروونها فقد كانت لهم مادّة قصصية تروى مشافهة جيلا بعد جيل وهذه المـادة القصصيـة تشكل أحد مصادر معرفة المجتمـع العربـي في مختلف فتراتـه. وقـد تطور هذا الفن فظهر القصص الديني الذي وظف لخدمة أهداف دينية ، وترفيـهية لإرضاء حاجيات الناس الماديـة والمعنويـة. غير أننا "لو عددنا مثل هذه الحكايات قصصا لكانت القصّة أقدم صورة للأدب في العالم لأنّ كلّ الشعوب الفطريّة تسمر على هذا النحو البدائي ولكن مثل هذه القصص إذا كانت لها دلالة شعبية فليست لها قيمة فنّيّة حتّى تعدّ جنسا أدبيّا"[3] ومن هذا المنطلق لا يعدّ غنيمي هلال الروايات التاريخيّة التي تختلط فيها الحقائق بالخرافات والأساطير من الفن القصصي لعدم توافر الصياغة الفنيّة التي تجعل منها ما يشبه الملاحم. أو القصص الملحميّة. والشيء نفسه بالنسبة للقصص الغزلي الذي نجده في أخبار العذريّين التي غالبا ما كانت متفرّقة أو متناقضة، تخلو من الاتساق والربط الذي يجمع بين الأحداث والشخصيّات.
غير أنّ هذا الرأي يجد معارضة من الآخرين الذين يرون أنّ العرب بحوزتهم تراثا ضخما يتمثّل في نماذج عاليّة كان لها تأثير لا في أدبنا القصصي الحديث فقط ، بل في الآداب العالمية الأخرى ذلك أنّ تطور المجتمع الإسلامي واللقاء الثقافي الذي تم ّبين الشعوب بعد الفتوحات خطا بهذا الفن خطوات مهمّة إلى الأمام ونشأت ألوان جديدة من القصص كالقصة الخرافـيـة أو الـقـصـة على لسـان الحيـوان، والقصة النادرة، والقصة المقامية، والقصة الفلسفية وقد قسّم النقاد الفنّ القصصي العربي إلى نوعين
نوع مترجم يتمثّل في كليلة ودمنة وألف ليلة وليلة التي سحرت عقول وعواطف ومشاعر الأدباء والقراء الغربيين ، وسموا هذا السفر الأدبي الخالـد بليـالي الشـرق.
ونوع أصيل يتمثّل في المقامات ورسالة الغفران وحي بن يقظان والسير الشعبية كسيـرة عنتـرة بـن شـداد ، وسيف بن ذي يـزن ، وقصص بني هـلال وغيرهـا من القصص التي ترضـي الخيـال الشعبـي وتعـكس أحـلامـه وطموحاته.
الفن القصصي الغربي الحديث
يجب أن نشير إلى أنّ الفن القصصي يمتدّ إلى الرواية والقصّة القصيرة فقد انتشرت الأولى انتشارا واسعا مع الحقبة الرومانسية التي جاءت حربا على الكلاسيكيّة التي استخدمت المسرح وسيلة لفنّها، ومن ثم تعد الرواية الرومانسية بديلا للمسرحيّة الكلاسيكيّة طبعا مع وجود أسباب كثيرة منها تطوير الرومانس السردي الشائع في القرون الوسطى، وتفكك المرويات القديمة، واعادة صوغ للمرويات الشعبية، واستعادة حديثة للملاحم القديمة، وتهذيب للآداب الكرنفالية، كما عدّ البعض الرواية ملحمة العصر الحديث مثلما نجد عند "لوكاش" لأنّها أوجدت قطيعة بين بطلها والعالم الذي يعيش فيه، فبطل الرواية نقيض بطل الملحمة. وذهب "غولدمان" الى شيء من ذلك حينما قال بأنها" قصة بحث عن قيم أصيلة، وفق كيفية منحطة في مجتمع منحط، انحطاطاً يتجلّى، فيما يتعلق بالبطل بشكل رئيسي، عبر التوسيط وتقليص القيم الأصلية إلى مستوى ضمني واختفائها بوصفها واقعاً جلياً.
ارتبط ظهور الرواية حسب هذه النظرة بانهيار سلّم القيم الذي كان سائداً في المجتمعات القديمة، والذي عبّرت عنه الملحمة حينما كان التواصل بين البطل الملحمي والعالم متماسكاً، فالبطل يربط نفسه مباشرة بذلك العالم، ويتحمّل مسؤولية الحفاظ عليه. وبظهور المجتمعات الحديثة، اضطربت العلاقة بين البطل والعالم. لم يعد البطل مسؤولاً عن العالم الذي انحطّت القيم فيه، وانهارت العلاقات التقليدية التي تفترض الصدق المطلق والمسؤولية الكاملة، والوفاء المطلق نجد ذلك بارزا في روايات مثل (دون كيشوت) لـ سرفانتيس و(الأحمر والأسود) لــ ستندال و(مدام بوفاري) لـ فلوبير . وهناك روايات كثيرة تبين الظروف الاجتماعية والصراعات الفكريّة وتصور واقعيّة المجتمع وما فيه من صراع كما في رواية البائسين لفكتور هيجو. والروايات الروسيّة مثل الحرب والسلم لتولستوي والإخوة كرامزوف لـ دوستويفسكي إلى غير ذلك من الروايات العالميّة.
ثم تلتها القصّة القصيرة من خلال قصة المعطف للروائي الروسي الكبير نيقولاي غوغول. نشرت في عام 1842. تحكي قصة معطف رجل يدعى أكاكي أكاكيفتش. وهي قصة إنسانية قال عنها الروائي الشهير تورغينيف: "كلنا خرجنا من معطف غوغول". ثمّ جاءت بعد ذلك أعمال أخرى تمثّلت في بداياتها أعمال لناثانيل هاوثورن إمام الحكايات عام 1894 ولإدجار آلان بو (1809 – 1849) في الثلاثينيات من القرن التاسع عشر، ثم لجي دي موباسان (1850 – 1893) في نهايات القرن نفسه) وكذا أعمال أنطون تشيخوف (1860 – 1904).
الفن القصصي العربي الحديث في العصر الحديث
بدأ تطور الفـن القصصي في الأدب العربـي في عصـر النهضـة العربيـة الحديثـة مع منتصف القـرن التاسع عشر ، حيث أسهم العديد من رواد النهضة الأدبية في نموه، تماشيا مع تطور المجتمع، وثمرة من ثمار النهضة، ومظهرا من مظاهرهـا . وقـد مرّ هذا التطـور بمـراحـل مـخـتـلفــة يمكن تلخيصها فيما يأتي:
- مرحلة الاقتباس من الأدب الغربي:
نجد في منتصف القرن 19 محاولات قصصيّة اقتبس بعضها من فنّ المقامة كما نجد عند وإبراهيم اليازجي 1847 - 1966 المويلحي 1858 - 1930 الذين وظفا هذا الفنّ في خدمة أهداف إصلاحيّة. وبعضها من فنّ القصص الغربيّ إمّا بتعريب هذه القصص كما فعل كلّ من بطرس البستاني 1819 – 1883 والمنفلوطي 1876 – 1924 وحافظ إبراهيم 1872 – 1932 أو ترجمته ترجمة دقيقة مثل ما فعل كلّ من إبراهيم عبد القادر المازني 1889 - 1949وأحمـد حسن الزيات 1885 – 1968 ومحمد عوض 895 – 1972.
تكمن أهميّة هذه المرحلة في كونها أنتجت العدد الكثير من النمـاذج القصصيـة المقتبسـة مـن الأدب الغربي تعريبا أو ترجمة حيث أقبل عليه الكتاب والقراء فكان بمثابة إرهـاص وتمهيــد للانتقــال إلى مـرحلـة جديــدة متطوّرة عما كانت عليه من قبل فظهرت مرحاـة التأليـــف والإبداع .
- مرحلة التأليف والإبداع:
فرضت هذه المرحلة حاجات المجتمع الجديدة ومدى تطوره ومواجهته للاستعمار الغربي؛ فبدأ المبدعون في تأليف الروايات التاريخيّة إذ ظلّ التأثير الغربي يمارس تأثيره بشكل واسع في اللون التاريخي للرواية. وأحسن من يمثّل هذه الفترة جورجي زيدان 1861 – 1914 بمجموعة من الروايات منها: أرمانوسـة المصرية ، الحجاج بن يوسف ، أبو مسلم الخراسـاني ، العباسـة أخـت الرشيـد، وعروس فرغانة وغيرهـا من القصـص ، حيث كان يلتزم بالحقائق التاريخية لدرجة أنه يثبت المصادر والمراجع التي اعتمدها ، في آخر الروايـة ، في حين ينشئ قصة مرافقة يقوم بأحداثها شخصيات تاريخية حقيقية وخيالية ، موازية لأحداث التاريـخ. متأثرا في ذلك بـ (ولتر سكوت) و(الاسكندر دوماس) غير أنّ هذين كانا يجعلان من التاريخ أداة للفن القصصي ، ويريان أن التاريخ ما هو إلا مادة تستغــل وتوظف لخدمـة الفـن القصصـي بينما جورجي زيدان كان يصر على توظيف العنصر القصصي لخدمة الحقائق التاريخية. ونجد روائيّا آخر هو محمد فريد أبو حديـد قد ألف عددا من الروايات استقى موضوعاتهــا مــن التاريـخ العربي مثل روايته "الوعاء المرمري " و "زنوبيا ملكة تدمر " و "أبو الفوارس عنترة " ..إلخ ، لـم يلتــزم فيها بالأحـداث التاريخيـة ، بـل وظّفها بشكل فنّي لخدمـة هدفـه القصـصـي وغــايتـــه الاجتماعيــة القوميـة ، وبخاصة ظهور الوعي القومي ، والكفـاح ضد الاستعمـار ، ممـا يفـرض العودة إلى التاريخ لاستنهاض الهمم وبث الوعي القومي بهويتنا وحضارتنا واستقلالنا. وألّف أيضا نجيب محفوظ ثلاث روايات تاريخيّة هي : كفـاح طيبــة ، ورادوبيـــس ، وعبــث الأقـدار من أصل ثلاثين رواية كان عازما على كتابتها.
يثبت بعض الدارسين أن رواية زينب لمحمد حسين هيكل هي أوّل رواية فنّية عربية نشرت سنة 1912 جسّدت القواعـد الفنيـة للروايـة بمفهومها الغربي مع استيحاء مادتها وموضوعهـا من الواقـع الوطني المحلـي والقومـي. هذه الروايـة أحدثت تأثيرا كبيـرا في فـن الرواية مـن حيث شكلهـا ومضمونهـا ، ودشنت حقبـة جديــدة في تطـور الروايــة العربيـة . غير أن البحث الجديد كما جاء في كتاب بواكير الرواية دراسة في تشكّل الرواية العربيّة لمحمد سيّد عبد التواب، أثبت أنّ رواية (زينب) ليست الرواية العربية الأولى، لكن رائد الرواية العربية هو اللبناني خليل أفندي الخوري في روايته (وي.. إذن لست بإفرنجي) التي سبقت رواية هيكل بنحو نصف قرن.
أمّا من الذي أرسوا قواعد الرواية الفنّيّة العربيّة وطوعوها للواقع المصري المحلي وحاجيـات المجتمــع والمرحلة التاريخية الـتـي يـمـر بـهـا ، توفيق الحكيم في أعماله الـرائـدة عـودة الـروح " ، و" عصفور من الشـرق " ، و " يوميـات نائب في الأريـاف ".
مرحلة النضج والازدهار
وهكذا انطلقت الرواية العربية نحو الآفاق حتى وصلت إلى العالمية مع جائزة نوبل والروائي نجيب محفوظ؛ حيث تمّ نضجها واكتمل بناؤها فنّيا من حيث الشكل والمضمون، ويمكن التأريخ لهذه المرحلة بالحرب الكونيّة الثانيّة مع الأديب العالمي نجيب محفوظ الذي انتهج مسارا خاصّا به أظهر من خلاله عبقريّة فذّة صنّفته مع متقدّمي الكتاب العالميين فنجده رومانسيّا وواقعيّا اجتماعيّا في مرحلة الأربعينيّات من خلال مجموعة من الأعمال مثل (القاهرة الجديدة) و (خان الخليلي) و (بداية ونهاية) ثمّ واقعيّا نفسيّا في (السراب)، ثمّ واقعيّا نقديّا وجوديّا فـي الخمسينـات والستينـات، ثمّ مرحلة التجريب حيث حاول أن يدمج التجارب السابقة بأشكل فنيّة جديدة حدثيّة، فوظّف الأساطير والأحلام وتيّر الوعي وتداعي الأفكار وغيرها.
ولم يكن نجيب وحده في الساحة فقد ظهر مبدعون في مستواه أو أكثر مثل محمـد عبد الحليـم عبد الـلـه وعبد السـلام العجيلي والعديـد من أعمال يوسـف السبـاعي وإحسـان عبــد القـدوس ، والطيب صالـح ، والواقعيـة الاشتراكيـة عبـد الرحمــن الشرقاوي ويوسـف إدريس وحنا مينـة وغسان كنفاني ومحمد ديب والطاهر وطار ورشيد بوجدرة وغيرهـم. وقد تميّزت هذه المرحلة بنضج وازدهار الفن الروائي بمختلف أشكاله واتجاهاته مخترقة الحدود العربيّة إلى مختلف أنحاء العالم من خلال ترجمة الأعمال الروائيّة إلى اللغات الأخرى كالإنكليزيـة والفرنسيـة والإسبانيـة والألمانيـة والروسيـة وحتى اليابانيــة والصينية وغيرها من اللغات.
والعالم العربي يعج بالمبدعين الروائيين في كل الأقطار وعلى مستوى عال جدا.
أمّا القصّة القصيرة فكان لها تواجد مكثّف ايضا في النتاج العربي فيذكر النقاد أنّ قصة (في القطار) أوّل قصّة قصيرة فنّيّة في البلاد العربية لمحمد تيمور سنة 1917، بل يرى غيرهم أن قصّة مخائيل نعيمة (سنتها الجديدة) سنة 1914 هي أوّل قصّة قصيرة فنيّة عربيّة وجاء بعد ذلك العديد من المبدعين مثل طاهر لا شين وعيسى عبيد ومحمود تيمور ثم جاء بعدهم مجموعة أخرى أسهمت في علو بناء القصة القصيرة منهم على سبيل المثال يحيى حقي، يوسف إدريس، محمود سيف الدين الإيراني وهو فلسطيني مقيم بالأردن، زكريا تامر، محمد خضيّر، محمد زفزاف، خيري شلبي، علي عبدالله خليفة (في بعض مجموعاته)، عبدالعزيز مشري (بعد مجموعته الأولى موت على الماء)، يوسف أبو رية.
ظهر هذا الفن مع تطوُّر الحياة بمقوِّمات وخصائص حديثة، وأمسى أقرب الفنون التصاقًا بروح العصر، حيث تصوِّر جانبًا من الحياة الواقعية، وبالأحرى الواقع المحتمل حدوثه، ومن خلالها يسعى الكاتب إلى تحليل شخصية معينة أو حادث أو ظاهرة، ولكن دون الاهتمام بالتفاصيل من غير أن يكون ملزما ببداية أو نهاية وهي قبل ذلك منظومة لغوية لها طريقة خاصَّة في استعمال عناصرها من سرد وحوار ووصف.
الفرق بين الرواية والقصّة:
يفرّق بينهما من خلال جملة من العلامات الفارقة هي:
1 الطول: القصة القصيرة ما بين خمس صفحات وثلاثين صفحة وهو أقصى طول لها، وما زاد عن ذلك حتى السبعين هو رواية قصيرة وما زاد عن ذلك دخل في نطاق رواية[4] وما قلّ عن خمس صفحات سمّاه النقاد الأقصوصة وهناك مصطلحات جديدة مثل القصة القصيرة جدّا، والقصّة الومضة لتناسب المساحات في الصحف. ويجب أن نشير أنّ الطول فارق أوّلي وليس جوهريّا فقد قال (فرانك أوكونور Frank O'Connor كاتب وناقد وروائي إيرلندي 1903 – 1966) "إن الفرق بين الرواية والقصّة القصيرة أساسا ليس فارقا في الطول"[5]
2 الرؤية: هي في الرواية عامّة كبيرة؛ فالروائي يرى الإنسانية جمعاء أو على الأقل يرى قطاعا كبيرا منها، بينما في القصة القصيرة فكأنّ الروائيّ رجل جالس في غرفة يرى من ثقب الباب أو من خصاص النافذة شيئا ما. غير أنّه قد تكون كلّ من الرواية والقصة عن رؤية واحدة؛ حيرة الإنسان بين عقله وقلبه، أو بين إمكاناته وقدره، وبين الخير والشر...
3 الزمن: زمن الرواية طويل قد يمتد إلى أجيال، في حين زمن القصة لا يزيد عن يوم غالبا.
4 الشخصيّات: شخصيات الرواية كثيرون وتحرص على رسم صورهم وملامحهم الجسمانيّة والنفسيّة والعقليّة، وظروفهم الاقتصاديّة والثقافيّة والمعيشيّة وسلوكاتهم في مواقف مختلفة. في حين القصّة غير مطالبة بذلك لأنّها تهتم بتصوير شخصيّة واحدة أو اثنين على الأكثر.
5 الأحداث: تتعدّد الأحداث في الرواية وتتشابك وتتصاعد من البسيط إلى المعقّد بينما القصة لا تحتمل غير حدث واحد؛ إذ قد تكتفي بتصوير لحظة شعوريّة لحدث تم أو سيتم، إذ يمكن أن تكون مجرّد صورة، أو تشخيص حالة أو رحلة عابرة في أعماق شخصيّة حائرة أو ثائرة[6].
6 البناء: ويقصد به الشكل أو المعمار الفنّي قد لا يظهر كثيرا في الرواية لطولها إلا في الروايات الناضجة لكبار الروائيّين، ولكن في القصّة قد يظهر ويبدأ مع أوّل كلمة فيها ليشرع القاص متجّها نحو هدفه.
7 اللغة: يملك الروائي متسعا لوصف ما يريد وليدبج العبارات المطوّلة ليرسم صورة كاملة وتفصيليّة للحدث ونتائجه والشخصيات وأعماقها، وفي الرواية يمكن أن تكون "هناك فرصة للعبارات الشعريّة والألفاظ الفضفاضة والتكرار المؤكّد للمعنى والاستدعاء المحرّض للمشاركة، والمستنفر للمشاعر"[7]ولا يكون ذلك في القصّة لأنها نص مكثّف لا حشو فيه ولا تأكيد ولا تكرار كأنّه لبنات كل واحدة في مكانها، والحاصل أن لغة القصة غير لغة الرواية.
8 المكان: تعدّد الأحداث في الرواية يقتضي تعدّد الزمان والمكان. في حين أن القصة لا تحتمل أكثر من مكان واحد.
9 الأسلوب: هو التقنيّة الفنيّة التي بها يطرح القاص فكرته وأمّا في الرواية فيتذرّع بأساليب تتنوّع بتنوّع المواضيع والشخصيّات حيث يكون السرد والمونولوج وغيرها من الأمور التي يوضّح بها الحدث.
ولا يحسب الصراع من الفروق بينهما لأنّه يكاد يكون ملمحا رئيسا في الرواية ومحدودا أو منعدما في القصة. مع الإشارة إلى أنّهما مستمدّان من منبع واحد هو القصّ.
خصائص القصّة الفنيّة:
للقصة القصيرة خصائص أثبتها النقاد وهي عناصر مهمة بحيث افتقاد أي خصيّة منها لا يجعل منها قصّة قصيرة مع الإشارة إلى أنّ الخصائص غير العناصر التي هي مكونات القصّة من شخصيّات وأحداث وبناء ولغة ... وأن هذه العناصر تشترك في تكوين الخصائص.
1 - الوحدة: حيث تشمل على فكرة واحدة تتضمّن حدثا واحدا، وشخصيّة رئيسيّة واحدة ويطالعها القارئ في جلسة واحدة. فلا يزج الكاتب بأي فكرة مغايرة لفكرته أو أي عبارة شعريّة أعجبته لا تخدم القصة.
2 - التكثيف: التوجّه مباشرة نحو الهدف دون مقدّمات من الكلمة الأولى في القصّة، فلا بد من التكثيف بحيث كلّ كلمة لها أهمّيتها داخل القصّة، فلا استطراد ولا شرح. القصة القصيرة - كما كان يقول يوسف إدريس – الرصاصة.
3 – الدراما: والمقصود بها خلق الإحساس بالحيويّة والديناميكيّة والحرارة حتى لو لم يكن هناك صراع خارجي ولم تكن غير شخصيّة واحدة، قوّة القصّة في أنّها تثير شهوة القارئ في معرفة ما يجري متلهّفا لمطالعة السطور لاكتشاف الجديد باعتماد أساليب التشويق
[1] غنيمي هلال، النقد الأدبي الحديث، دار العودة – بيروت، 1973، ص 492
[2] م ن، ص523، وانظر الأدب المقارن للكاتب نفسه ص 177
[3] غنيمي هلال، النقد الأدبي الحديث، ص 524
[4] فؤاد قنديل، فن كتابة القصة، الهيئة العامة لقصور الثقافة، 2002، ص 39
[5] م ن، ص 41
[6] م ن، ص 45
[7] نفسه، ص 48
المحاضرة الثالثة
أسس نقد النثر عند ميخائيل نعيمة
ميخائيل نعيمة 1989 – 1988 مفكّر وناقد أديب لبنانيّ، فهو شاعر وقاصّ ومسرحيّ وناقد وكاتب مقال، فهوبلا منازع أحد قادة النّهضة الفكريّة والثّقافيّة العربيّة، وأحد مؤسّسي الرابطة القلميّة. يكتب بلغات ثلاث العربيّة والإنجليزيّة والروسيّة. فكتب القصة والرواية والمسرح والشعر والنقد ومن الكتب النقديّة البارزة عنده كتاب "الغربال".
أنشأ أدباء المهجر الشمالي في نيويورك رابطة أدبية باسم " الرابطة القلمية " بتاريخ 20 أبريل 1920 تولى رئاستها جبران خليل جبران وكان ميخائيل نعيمة مستشارها وقد كتب صدر قانونها فكان ما نصّه: " هذه الروح الجديدة التي نرى الخروج بآرائنا من دور الجمود والتقليد إلى دور الاحتكار في جميل الأساليب والمعاني حرية في نظرنا بكل تنشيط ومؤازرة، فهي أمل اليوم، وركن الغد"[1]
كتاب الغربال:
الغِرْبال من غربل الشيء إذا نخله، والغِرْبالُ: ما غُرْبِل به،وغربل : أ ي فرّق بين الجيِّد والرديء، وهي سنّة الطبيعة، ويقدّم لنا الناقد مهمّة النقد أو الغربلة التي هي "مهنة الناقد... الذي يغربل الآثار الأدبية لا غربلة أصحابها... والقصد من النقد الأدبي هو أن يميّز الصالح والطالح، والجميل والقبيح وبين الصحيح والفاسد ... والناقد مهما كان ماهراً لدرجة الكمال، وكان غرباله آية في الدقة، فهو لا ينجو من زلة أو هفوة، فقد يرى القبيح جميلا، أو يحسب الصحيح فاسدا وما ذاك إلا لأنه بشر... فلنحاسبْ الناقدين بنواياهم أوّلا، فإن أخلصوا النيّة فزلَّاتهم مغفورة لهم... فإن كانت محكمة الصنع متناسقة الثقوب وأجادوا هم استعمالها فذاك حدّ ما يحقّ لنا مطالبتهم به"[2]. فالنقد ينصب على العمل الأدبي وليس على صاحبه، لمعرفة صحيحه من خطئه، وجميله من قبيحه، غير أنّ مفهوم القبح والجمال نسبيّ وكذا ثنائيّة الصحيح والفاسد فمتى يكون الشيء صحيحا أو فاسدا؟ وما هو المقياس الذي يقاس به الصواب والفساد؟ هل هو المقياس اللغوي أم الأخلاقي أم الفكري ؟.
مقالات الغربال اثنان وعشرون مقالة نشرت من قبل في مجلات وجرائد يوميّة جمعها في هذا الكتاب مسبوقة بمقدّمة للأستاذ العقاد. وطبع الكتاب عام 1923، وبهذا يكون الكتاب بمثابة الغربلة التي أسّست لمنهج نعيمة النقدي في حكمه على الأعمال الأدبية التي تناولها سواء في الجانب النظري أم التطبيقيّ. بدأ العقاد مقدّمته فيه بقوله "صفاء في الذهن، واستقامة في النقد، وغيرة على الإصلاح، وفهم لوظيفة الأدب، وقبس من الفلسفة، ولذعة من التهكّم - هذه خلال واضحة تطالعك من هذا "الغربال" الذي يطلّ القارئ من خلاله على كثير من الطرائف البارعة والحقائق القيّمة"[3]. فهو من خلال غرباله يحدد المفهوم الذي يرى أن يكون عليه الأدب، بحيث يضع - إلى جانب ذلك - الشروط النقدية التي يراها لازمة للناقد الالتزام بها.
الأديب والأدب في عيون الناقد
يريد نعيمة من المبدعين أن يكونوا متحرّرين من أي تقليد أو تحجّر لأنّهم هم - وحدهم - المؤهلون لتناول حاجياتهم الفرديّة، وأنّهم – وحدهم - الذين تكتنفهم الأسرار التي لا يكشفونها إلا بالإبداع. كما تتجلى دعوته لهم في أن يجعلوا من ذواتهم مصدرا للإلهام لأنهم يغنون الذوات الأخرى التي تتلقى إبداعاتهم ذلك أنّ الأدب " الذي هو أدب، ليس إلا رسولا بين نفس الكاتب ونفس سواه، والأديب الذي يستحق أن يُدعى أديبا هو من يزود رسوله من قبله ولبّه"[4] كما أنّ الأديب الحق في رأيه هو من يداوي النفوس ويصلح الاعوجاج بها من خلال كشف المستور وتبيان الغامض. فيحرّك همم قرائه بما يكتب ويقضي على اليأس فيهم فيحوّل الحزين فيهم فرحان، "فرب قصيدة أثارت فيه عاطفة من العواطف. ومقالة تفجرت لها في نفسه ينابيع من القوى الكامنة، أو كلمة رفعت عن عينيه نقابا كثيفا.أو رواية قلبت إلحاده إلى إيمان، ويأسه إلى رجاء، وخموله إلى عزيمة، ورذيلة إلى فضيلة، تلك مزية قد خص بها الأدب وتلك مملكة الأدب لا ينازعه عليها منازع"[5]
الأدب عند نعيمة فنّ من الفنون، وقيمة الفنون روحيّة غير ماديّة، "في الحياة ما ليس له إلا قيمة روحيّة ومن ذلك الفنون، ومن ذلك الأدب"[6] ومن ثمّ فالأدب له قيمته الروحيّة وتكون مقاييسه روحيّة متعدّدة وغير ثابتة تتنوّع بتنوّع الأجناس الأدبيّة وتنوّع مضامينها وموضوعاتها حيث يفر ّق البعض بين المضمون والموضوع - إذ يمثل المضمون جوهر العمل الفنّي والمعبّر الأوّل عن مشاعر وعواطف الفنان بينما الموضوع هو فكرة العمل الفني الظاهريّة - وكذا تعدّد أذواق القرّاء من هنا كان تساؤل نعيمة: "كيف نحدّد قيمة الأدب؟ بماذا نقيس هذه القصيدة، أم تلك المقالة، أو القصة، أو الرواية؟ أمِن حيث طولها، أم قصرها، أم تنسيقها، أم معناها، أم موضوعها، أم نفعها؟ أم نقيسها بإقبال الناس عليها وبعدد طبعاتها؟ أم يستحيل قياسها بمقياس واحد ثابت؛ لأنّ تقديرها موقوف بذوق القارئ، والأذواق تختلف باختلاف الناس والأعصار والأمصار فلكلّ أن يقيس كيف يشاء وكلّ في رأيه مصيب"[7] وهي أسئلة مشروعة يمارسها القرّاء على ما يقرأون، والقرّاء تختلف خلفياتهم وثقافاتهم فما يريدها غير ما يريده ذاك، كلّ ينطلق من قناععته التي شكلتها عوامل متعدّدة. وهذا التغيير مستمرّ مع الزمن، فما نراه اليوم جميلا يأتي يوم ويكون عند أجيال قادمة قبيحا، والعكس صحيح أيضا. غير أنّ (نعيمة) يشير إلى أنّ هناك مقاييس ثابتة لا تتغيّر بتغيّر الزمان والمكان ويمثّل لذلك بجملة من الأعمال ما تزال جميلة يتسابق القراء على قراءتها واستحسانها معجبين بها كما أعجب بها قراؤها في زمانها مثل الإلياذة والأوديسة والمعلقات وأعمال شكسبير ... وغيرها من الأعمال التي ما تزال خالدة. فما السرّ في خلود هذه الأعمال وتعدّيها للزمان والمكان وبقائها على جمالها؟ قد تكون المقاييس التي نقيس بها نحن هذه الأعمال هي المقاييس نفسها التي قيست بها في زمانها وفي كلّ زمان. وهذا يعني أنّ للأدب مقاييس ثابتة تتجاوز الزمان والمكان ولا تعبث بها أمواج الحياة المتقلّبة وأذواق العالم المتضاربة وأزياء البشريّة المتبدّلة"[8] فهناك مقاييس خالدة لا يبليها الزمن ولا تعتق معه ولا تتقادم معه بل تزيدها الأيام جمالا ونضارة بل وهيبة أيضا.
ينوّع ميخائيل نعيمة أسلوبه أثناء حديثه عن الآثار الفنيّة الخالدة في محالة إقناع القارئ برأيه؛ حيث يستخدم أسلوب الإقناع من خلال إيراد الكثير من الأمثلة للآداب والفنون الخالدة، ويكثر من استخدام أسلوب الاستفهام بغرض السخرية من واقع الأعمال الأدبية في المشرق العربيّ، وكذا إحداث التأثير في نفوس المتلقِين وتحفيزهم للثورة على القديم لإنتاج أعمال أدبية خالدة وهو أسلوب استمدّه من اطّلاعه على النقد الرومانتيكي؛ إذ "كثيرا ما ينوِّع الرومانتيكي في أسلوبه ما بين استفهام وتعجُّب ونداء وتشخيص للأشياء مع مبالغة وجرأة في التصوير. والأسلوب الرومانتيكي لا يسير على وتيرة واحدة، فيتنوَّع عند الكاتب الواحد، من عاطفي مؤثِّر إلى ثوريٍّّ قوي، ومن ساخر متهكِّم إلى هادئ أليف"[9]. هذه المقاييس الخالدة هي مرتبطة بالحاجات الروحيّة المشتركة التي تكون بين الأفراد والأمم وهي نفسها المقاييس الثابتة التي بها يقاس الأدب وتقاس الفنون.
الحاجات الوحيّة/ المقاييس الخالدة عند ميخائيل نعيمة
1- حاجتنا إلى الإفصاح عن كل ما ينتابنا من العوامل النفسية من رجاء ويأس، وفوز وفشل، وإيمان وشكّ، وحبّ وكره، ولذّة وألم، وحزن وفرح، وخوف وطمأنينة، وكل ما يتراوح بين أقصى هذه العوامل وأدناها من الانفعالات والتأثرات"[10]. وهذا يعني التعبير عن التجربة الذاتية للمبدع، وربط الأدب بعلم النفس لكشف داخل الإنسان وبواطنه، وكذا انطلاق المبدع من عاطفته أي من فرديّته وذاتيّته. وهي نظرة استمدّها من النظرة المثاليّة التي ترى أنّ "لأدب تعبير عن الذات، أي تعبير عن العواطف والمشاعر، والأدب علم المشاعر والأحاسيس، القلب هو ضوء الحقيقة لا العقل"[11] ولا شكّ أن الخلود للأعمال الأدبيّة إنّما تأتيها من اعتمادها على العاطفة. هذه العاطفة التي افتقدها شعر شوقي كما يرى العقاد ويوافقه عليه نعيمة غير أن شعر شوقي النمتهم بضعف العاطفة فيه ما يزال خالدا يحفظه الناس ولا يحفظون شيئا من شعر العقاد ولا حتى نعيمة.
2 - "حاجتنا إلى نور نهتدي به في الحياة، وليس من نور نهتدي به غير نور الحقيقة - حقيقة ما في أنفسنا، وحقيقة ما في العالم من حولنا. فنحن وإن اختلف فهمنا عن الحقيقة لسنا لننكر أنّ في الحياة ما كان حقيقة في عهد آدم ولا يزال حقيقة حتى اليوم وسيبقى حقيقة حتى آخر الدهر"[12]. ولطالما انشغل الفلاسفة والمفكّرون والنقاد والأدباء بأن يعرف الإنسان حقيقة نفسه، بل اختلفوا في تحديد معنى الحقيقة فـ (كانط) يربطها بالشعور، ويرى (هيغل) أنّ الفنّ إنّما هو إدراك خاصّ للحقيقة ويرى غيرهما أن القلب هو ضوء الحقيقة، والجمال عند الرومانسيين هو الحقيقة وإن كانت الحقيقة عندهم "ذات طابع ذاتي، أسيرة لخيال الكاتب وعاطفته المشبوبة، وتتبدَّى في ثوب جديد ثائر[13]. فالبحث عن الحقيقة هو هاجس الإنسان الذي لا يتوقّف أبدا.
3- "حاجتنا إلى الجميل في كل شيء، ففي الروح عطش لا ينطفئ إلى الجمال، وكلّ ما فيه مظهر من مظاهر الجمال. فإنّا، وإن تضاربت أذواقنا في ما نحسبه جميلاً وما نحسبه قبيحاً، لا يمكننا التعامي عن أنّ في الحياة جمالاً مطلقاً لا يختلف فيه ذوقان". فالجميع ينشد الجمال وإن اختلفوا في تحديده هل يصدر من العقل أم القلب وهل الذوق مصدره اللمنطق أم الذاتيّة. ومع اختلاف الأذواق فإن في الحياة جمالا مطلقا لا يختلف حوله تعدّد الأذواق
4- حاجتنا إلى الموسيقى، ففي الروح ميل عجيب إلى الأصوات والألحان، لا ندرك كنهه، فهي تهتزُّ لقصف الرعد، ولخرير الماء ولحفيف الأوراق، لكنها تنكمش مع الأصوات المتنافرة، وتأنس وتنبسط بما تآلف منها. وهو ما يدل على انجذاب الإنسان إلى الطبيعة التي تكون مصدر إلهامه وإبداعه ولعل الموسيقى التي يكون الإنسان في حاجة إليها تتغيّر من زمن إلى آخر وهو بشير إلى التجديد في أوزان القصيدة العربية المستمدة من الطبيعة التي افتتن به الإنسان القديم غير أنّ ظروف طبيعته لا نعيشها نحن الآن ومن ثمّ لا بدّ من تغيير موسيقى الشعر تبعا لجمال طبيعتنا وأحوالنا الجماليّة.
النقد الأدبي والناقد
النقد الادبي عنده هو تقويم العواطف والأحاسيس والأفكار والتمييز بين جيدها ورديئها، وجميلها وقبيحها.
والناقد مبدع لأنّه يرفع الستار عن جوهر الأثر المنقود ويكشفه للآخرين ولصاحب الأثر نفسه، كما أنّ الناقد مولّد، يخلق كما يخلق الأديب، لأنه عندما يقوم بوضع المقاييس الادبية يكشف نفسه للآخرين وفي الواقع يولّد أفكارًا فهو اذا استحسن أمرًا لا يستحسنه لأنه حسن في ذاته، بل لأنه ينطبق على آرائه في الحسن، وكذلك اذا استهجن أمرًا فلعدم انطباق ذلك الامر على مقاييسه الفنية، فللناقد آراؤه في الجمال والحقّ، وهذه الآراء هي بنات ساعات جهاده الروحي...(
تشبّع نعيمة بالأدبين الروسي والإنجليزي فهو بالإضافة مطالعاته العربيّة فقد أعجب بالآداب العالميّة فأخذ الرومانسية من أمريكا والواقعية من روسيا فكان المبدع المثقّف الذي تعامل من الآداب العالمية التي تركت آثارها في إنتاجه وآرائه النقدية.
اقتفى نهج بيلنسكي - ناقد روسي - في النقد وهتف بشعار الأدب والحياة، مبيّنا أن الحياة والأدب توأمان
لا ينفصلان. فهو متأثّر بالمدرسة الواقعية واستوحى فنّه من الأدباء والنقّاد الروس، قال عن نفسه: فقد نهجت في القصة منهج الواقعية الروسية، وكذلك في القصيدة، وكذلك في النقد.
يرى نعيمة أن من أهم الاسباب التي أدت الى انحطاط الأدب في السابق هو ابتعاده عن الحياة بل انفصاله عنها لأنه لا حياة للأدب إلا من الحياة فهي له بمثابة الماء والهواء والغذاء للجسد، الادب الذي لا يتغذى من الحياة ليس أهلاً لأن يسمى أدباً.
حاول نتيجة لذلك تبسيط مفردات اللغة العربيّة وتخليصها من الزيادات والزخارف، وتقريبها إلى الأسلوب التصويريّ لواقع الأحداث.
حاول تجديد أصول النقد العربيّ بحيث طوّر الأدب العربي بشكلٍ يساير الحياة وتطوّرها، وجدّد المواضيع وابتعد قدر الإمكان عن المواضيع والأحاديث المكرّرة، ورفض أن يكون الأدب مجرد صدى للحياة، بل دعا فيه إلى التطوّر
تميّز نعيمة بصدقه في تصويره لقصصه، وتجنّب المبالغة في سرده للتفاصيل، وأدى هذا الأمر إلى تلمس الصدق الفنيّ والنفسي معاً في أعماله، بالإضافة لهذا فإنّه كان مجدداً في مفرداته وأساليبه، بحيث كان أسلوبه أقرب للوفاء والإخلاص للمعنى المراد إيصاله.
ميله إلى النزعة الصوفيّة في أعماله، بنقاء النفس وبساطة العيش، ويعود هذا الأمر لدراساته العميقة للديانات المسيحيّة والإسلاميّة وغيرها من الديانات، وتميّز ببساطة ووضوح الأسلوب، وكان صريحاً في مجال السرد والوصف والتصوير، لديه قدرة كبيرة على الإقناع والجدل العقلي السلس، وكان ميّالاً إلى التفاؤل في أسلوبه، ومبشِّراً بالحب والجمال والخير.
يدعو نعيمة إلى ضرورة تحرر الأدب من التقليد والتحجر، وهي مهمة ملقاة على عاتق الأديب، باعتباره المؤهل الأول في تناول حاجياته الفردية، وفي كونه كائنا تكتنفه أسرار كثيرة، لا يكشف عنها إلا الأدب.
يدعو الأدباء إلى أن يجعلوا من ذواتهم مصدرا للإلهام، لأن في ذلك إغناء لباقي الذوات التي تتلقى إبداعاتهم والأديب الحقيقي هو من طاوعته نفسه في كشف المستور وتبيان الغامض، والتعبير عن اليأس كما التمني والرجاء. هذا الأدب الذي يُداوي النفوس، ويُصلِح ما اعوج منها. كما يحرك الهمم، وينفس الكرب، ويبدل الحزن فرحا، والإلحاد إيمانا. وهو الأدب الذي يصيب هدفه، فيطهر النفوس ويغذي الروح من جديد.
[1] محمد عبد المنعم خفاجي،حركات التجديد في الشعر الحديث، دار الوفاء لدينا الطباعة والنشر ط1/ 2002م، ص 177
[2] ميخائيل نعيمة، الغربال، المطبعة العصريّة 1923، ص14/17
[3] المرجع نفسه، ص 6
[4] م ن، ص 28
[5] م ن، ص 28
[6] م ن، ص 68
[7] م ن، ص 69
[8] م ن، ص 71
[9] محمد غنيمي هلال الرومانتيكيّة، دار العودة – بيروت، 1973، ص240
[10] الغربال، ص 72
[11] شكري عزيز الماضي، في نظريّة الأدب، دار المنتخب العربي للدراسات والنشر والتوزيع – بيروت ، ط1/1993، ص 53
[12] الغربال، ص 72.
[13] محمد غنيمي هلال، الرومانتيكيّة، ص 19
المحاضرة 2
نقد النثر في الوسيلة الأدبيّة للمرصفيّ
المرصفي في كلمات:
إذا كنا نعرف سنة وفاته التي هي 1889 فإنّنا نجهل ميلاده بالضبط ورجّح تاريخ 1815. تربّى المرصفي في أسرة علم فكان والده أستاذا بالأزهر ممّا جعله يحرص على تنشئته تنشئة علميّة وعلى الرغم من فقدانه لبصره وهو ابن الثالثة، فقد عوّضه الله قوة الحافظة سرعة الحفظ؛ فحفظ القرآن وكثيرا من المتون مكّنته من التدريس بالأزهر ثمّ دار العلوم/ الجامعة فيما بعد. تعلّم اللغة الفرنسيّة وأتقنها من خلاله لغة برايل. بل وترجم نصوصا من كتاب الخرافات Les fables لصاحبه "لا فونتان". La Fontaine
يعدّ المرصفيّ أول أستاذ للأدب العربي والنقد في مدرسة دار العلوم العليا، إلى جانب ذلك أصبح الشيخ عضوا في المجلس الأعلى للتعليم المصري، وكان علي مبارك رئيسا لهذا المجلس، وكانت آراء المرصفي وأفكاره البناءة عنصرا داعما لهذا المجلس ونشاطاته. من أهم مؤلّفاته: الوسيلة الأدبيّة إلى العلوم العربيّة
الوسيلة موسوعة فكريّة جمعت علوم اللغة العربيّة تقع في مجلدين، يحتوي الأوّل على 214 صفحة طبع عام 1875، والثاني ـ ويحتوي الثاني على703 صفحة، وطبع عام 1879، ولا توجد طبعات أخرى للكتاب، ويتضمن الكتابان مجموعة من المحاضرات التي ألقاها المرصفيّ في دار العلوم؛ حيث تناول بالدرس أكثر من اثني عشر علمًا، مثل اللغة وأصولها، والنحو، والصرف، والبلاغة، والعروض، والقوافي، والإملاء، وصناعة الترسل، وقرض الشعر، وتاريخ نشأة الفنون وتدوين العلوم، وتاريخ التربية، وتاريخ الكتّاب، والنقد الأدبي. وقد أملى المرصفي كتابه على طلبته وقد نقله إلى القراء الشيخ حسن أبو زيد سلامه، الذي أشرف على طباعته فيما بعد.
يرى النقّاد أنّ المرصفي شائق في محاضراته؛ إذ كان يعرض النصوص الأدبيّة ثم يتعرّض لنقدها، وما يعقده من موازنات بين مجموعة من النصوص القديمة والحديثة، بأسلوب لم يألفه ذوق عصره.
o من أسباب اهتمام القراء بالوسيلة:
- إلقاء المحاضرات على طلبة دار العلوم.
- نشر فصولها في مجلة (روضة المدارس) وهو ما سمح بأن يطّلع عليها عدد كبير من القراء.
- عدّ المرصفي عالما لغوّيا وناقدا أدبيّا يتّكئ على منابع النقد العربي القديم.
o أهميّة المرصفي وكتابه:
اعترف كثير من الرواد[1] بصورة قاطعة أنّ الكتاب قد أسهم في تشكيل مكوناتهم الثقافيّة، وأكّدوا أنّهم تتلمذوا على يديه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. وهو ما يعني أنّ الكتاب قد أسهم بشكل كبير في تغيير الذوق والحاسة الفنية، وكوّن مدرسة أدبية كان لها الفضل على أهل الكلمة والرأي والفكر والإبداع.
يجب أن نشير أن المرصفي وهو يملي محاضراته لم يكن يقصد أنّه يجدّد أصول النقد العربي ولكن على العكس من ذلك تماما؛ فقد كان يريد أن ينفخ فيها ليعيدها إلى ما كانت عليه، ذلك أنّ حركة التجديد في القرن التاسع عشر الميلادي لم تكن قد تهيأت لها الظروف المناسبة للتجديد الذي لا يمكن أن يكون ما لم يكن مرتكزا على قاعدة صلبة ثابتة ينطلق منها. ولذلك نجد المرصفي يقرّ بآراء القدامى كالسكّاكيّ وحازم القرطاجنّيّ وابن رشيق وغيرهم... بل ينقل نصوصا كاملة من القدامى كما فعل مع ابن خلدون في تعريفه للشعر.
o عنوان الكتاب: : الوسيلة الأدبيّة إلى العلوم العربيّة
جاء في لسان العرب: "الوَسِيلَةُ: المَنْزِلة عِنْدَ المَلِك. والوَسِيلة: الدَّرَجة. والوَسِيلة: القُرْبة. ووَسَّلَ فلانٌ إِلى اللَّهِ وَسِيلَةً إِذا عَمِل عَمَلًا تقرَّب بِهِ إِليه. والوَاسِل: الراغِبُ إِلى اللَّهِ؛ قَالَ لَبِيدٌ:
أَرى الناسَ لَا يَدْرونَ مَا قَدْرُ أَمرِهم، ... بَلى كلُّ ذِي رَأْيٍ إِلى اللَّهِ وَاسِلُ
وتَوَسَّلَ إِليه بوَسِيلَةٍ إِذا تقرَّب إِليه بعَمَل. وتَوَسَّلَ إِليه بِكَذَا: تقرَّب إِليه بحُرْمَةِ آصِرةٍ تُعْطفه عَلَيْهِ. والوَسِيلَةُ: الوُصْلة والقُرْبى، وَجَمْعُهَا الوَسَائِل، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أُولئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ. الإسراء 57 والوَسِيلَةُ مَا يُتَقَرَّبُ بِهِ إِلى الغَيْر، وَالْجَمْعُ الوُسُلُ والوَسَائِلُ"[2]. فالحاصل أنّ الوسيلة منزلة أو درجة يصلها المرء، أو هي ما يتقرّب بها الإنسان إلى شيء ما، ومن ثمّ فالوسيلة الأدبيّة هي ما يتقرّب بها الدارس إلى علوم اللغة العربيّة وتوصله إذا تمكّن منها إلى درجة عاليّة. وهو ما كان يريده المرصفيّ من محاضراته/ كتابه
وسيلة يتقرّب بها إلى العلوم العربيّة، وينفذ إلى أعماقها ويسبر أغوارها.
من القضايا التي أثارها المرصفيّ في كتابه:
- الحديث عن اللهجات العامية بطريقة موضوعيّة.
- دراسة علوم جديدة، مثل فقه اللغة.
- التناول النقدي لنصوص شعراء وكتاب معاصرين للمرصفي بطريقة تحليل النصوص وتذوّقها.
- محاولة تحليل الأدب بصورة تقترب ممّا يعرف الآن باسم التحليل النفسي كمنهج سياقيّ للأدب أو المنهج النفسي في النقد الأدبي.
- أوّل من أرسى قواعد المنهج التاريخي في الدرس الأدبيّ ومن خلال هذا المنهج قسّم الشعراء إلى طبقات ثلاث:
- طبقة الجاهليين والإسلاميين من المهلهل إلى بشار بن برد.
- طبقة المحدثين الحارصين على موافقة العرب المجتهدين في سلوك طرائقهم، من أبي نواس إلى قبيل القاضي الفاضل[3].
- طبقة الشعراء الذين غلب عليهم استعمال النكات والإفراط في مراعاة البديع من القاضي الفاضل إلى عصر المرصفيّ.
وقد درس خصائص كل طبقة ممّا جعله يضع اللبنة الأولى للمنهج التاريخي في دراسة الأدب
وهو كتاب ينهج فيه طريقة الآمالي لأبي علي القالي والكامل للمبرّد وغيرهما... ويختلف عنهم في أنّه لا يقتصر على الأدب وروايته ولكنّه يضيف إلى ذلك "جميع علوم اللغة العربيّة من نحو وصرف وعروض وفصاحة وبيان وبديع ومعان ثمّ الأدب بفرعيه الشعر والنثر، متحدّثا عن كلّ فنّ على حدة ولكن على طريقة الاستطراد والتداعي المعروفة في كب الآمالي القديمة"[4] وهو ما يدلّ على مدى تمكّنه من التراث اللغوي والأدبي إذ كثيرا ما كان يستشهد بمحفوظاته الضخمة التي تدلّ على ذوق "سليم في الاختيار كما ينمّ حديثه عن علوم اللغة عن فقه وتعمّق وحافظة جبّارة فضلا عن حديثه عن رائدي البعث الأدبي في عصره محمود سامي البارودي الشاعر وعبد الله فكري الناثر وإيراده عددا كبيرا من قصائد البارودي الشعريّة ومقطوعات عبد الله فكري النثريّة والموازنة بينهما وبين شعر القدماء ونثرهم".[5] وهذه في حدّ ذاتها إضافة جديدة لما كان سائدا في عصره. مستفيدا من كلّ ما قرأه سابقا من علوم اللغة وموازنة الآمديّ.
يعدّ الكتاب الأوّل من الوشيلة كأنّه مدخل للأفكار التي يريد أن يتعرّض لها في الكتاب الثاني، فقد ذكر فيه "القواعد وتعريفات العلوم وبعض المسائل النظريّة التي تتصل بالأدب ولا تدخل في مباحثه واهتمّ أيضا بالتأصيل النظريّ للمعارف الإنسانيّة"[6] فنراه يعرف اللغة والصرف والاشتقاق والنحو والمعاني والبيان والبديع والعروض والقوافي والإنشاء والنظم والكتابة والتاريخ فهو مثلا يعرّف البيان بقوله: "علم يبيّن المجاز والكناية"[7] ويعرّف النظم بقوله: "ويقال له القريض وقرض الشعر هو علم يبيّن كيفيّة النظم في الأغراض المختلفة من حكم ووعظ ونسيب ومدح وعتب وتعطّف وتأديب وغير ذلك"[8] وقد ختم الكتاب الأوّل بحديثه عن أحسن الطرائق لتحصيل علوم العربيّة واختلافها بحسب العصور وفيها تظهر "ثقافة المرصفي الغزيرة، ومواهبه، وتفتّحه على الجديد، وإحساسه بأنّ الحياة دائمة التجدّد في كلّ شيء"[9]
الكتاب الثاني سياحة عميقة في علوم البلاغة الثلاثة هدفها مواجهة النصّ الأدبيّ وتذوّقه، ويكون المرصفي بكتابه/ المجلّد الثاني قد "أسهم في تغيير الذوق والحساسيّة الفنيّة وكوّن مدرسة أدبيّة لها الفضل في بعث النقد العربي الحديث، بل لقد ألهم الروّاد في مجال الإبداع الفنّي فلا شكّ أنّه من مفجّري طاقة البارودي الشعريّة ومن الذين سدّدوا طريقه"[10] وبحديثه عن مواجهة النصّ وقراءته وتذوّقه وبيان ما فيه - وهي مشكلة تواجه النقد الحديث – يكون قد أسّس للنقد الجمالي الذي يكون هو أحد روّاده. ويبدأ هذا المجلّد بالمقصد الثالث في فنون البلاغة حيث تحدّث فيه عن فنّ البيان فتناول المجاز والاستعارة والكناية ثم تعرّض لعلم المعاني فتناول الجملة وأجزاءها ثم تفرّغ لعلم البديع.
يلاحظ أنّه أسهب كثيرا في موضوعات البديع حتّى أنّه تجاوز مئة صفحة (51 – 168)مع أنّها محسّنات لفظيّة "تحذلق علماء البديع المتأخّرون في سردها والتفريق بينها، مع أنّها كلّها لا تخرج عن كونها محسّنات لفظيّة عميقة كانت من الأسباب الرئيسيّة في تحويل الأدب العربيّ كلّه إلى زخارف خاويّة من كلّ معنى عميق أو إحساس صادق، وكأنّما الأدب قد استحال إلى مجرّد زخارف"[11] وهو ما يبيّن موقف الدكتور محمد مندور من المحسّنات البديعيّة وكأنّه يعترض عليه فعل ذلك إذ أسهب في الحديث عنها بينما ترك علمي البيان والمعاني الذي يراهما أرفع شأنا من فنون البديع الذي هو أشبه بالفنون التشكيليّة أو ما يسمّونه بفن الأرابيسك التي تقوم على زخرفة الظاهر بينما علم البيان هو "دراسة أصليّة لوسائل أكيدة من وسائل التصوير الأدبيّ، بل الخلق الجماليّ عن طريق التشبيهات والاستعارات والمجازات أي الصور الأدبيّة التي تميّز الأدب كفنّ تصويريّ عن غيره من أنواع الكتابة التقريريّة، وعلى حين يعتبر علم المعاني دراسة للتراكيب اللغويّة وطرائق الأداء والتلوين الفكريّ والعاطفيّ ممّا يقابل علمي الأسلوب Stylistique والتراكيبSyntaxe في اللغات الأوربيّة"[12].
o المبادئ التي يقوم عليها الشعر عند المرصفي:
يرى المرصفي أنّه حتى تتمكّن الملكة من صاحبها لا بدّ من توافر ثلاث مراحل:
1 مطالعة الجيّد من الإنتاج والحفظ.
2 الدربة الطويلة والمستمرّة
3 نسيان المحفوظ لتمحى رسومه الحرفيّة
لا تنمو ملكة الشعر في راي المرصفي إلا بكثرة بحفظ مطالعة الجيّد من الشعر، وهي الطريقة الوحيدة منذ العصور القديمة التي يتمّ من خلالها تحصيل ملكة الشعر. وبعد حصول الملكة لا بدّ من أن يتدرّب طويلا على نظم الشعر والإكثار منه حتى تستحكم الملكة منه. وهو رأي رآه من قبل الناقد الفرنسيّ الكبير جورج دي هامل Georges Duhamel[13] الذي تحدّث في كتابه "دفاعا عن الأدب " عن الروائيّ أونوريه دي بالزاك Honoré de Balzac[14] أنّه قد سوّد مئات الصفحات قبل أن يعثر على بلزاك. ثمّ بعد ذلك عليه أن ينسى ذلك المحفوظ حتّى تنسى رسومه الحرفيّة وتبقى الفكرة فقط يستطيع أن يعبّر عنها بطريقة أخرى فيها جدّة.
أسلوب المرصفيّ في الوسيلة علميّ حيث كان قادرا "على الفحص والتحقيق والتدقيق والتأمّل العميق والوصول بعد ذلك إلى نتائج محدّدة واضحة لا تضيع في خضمّ الاستطرادات والنقول وهو ما يسهّل عمليّة التمييز بين آرائه وآراء من يستشهد بأشعارهم وأقوالهم، ثمّ كان حريصا على نسبة النقول التي ينقلها إلى أصحابها، وهذه مسألة علميّة لم تكن معروفة في دنيا التأليف حينذاك"[15] وهو ما يؤكّد نظرة المرصفي الثاقبة وتميّزه عن أقرانه بما اكتسبه من ثقافة عاليّة ناجمة عن مطالعات عميقة للتراث الأدبي والنقدي.
يمكن القول أخيرا إنّ الشيخ المرصفي كان من روّاد البعث الأدبي المعاصر ومن بناته الأصليّين من خلال ما كتبه عن صناعتي الشعر والنثر وطريقة تعلّمهما والموازنات التي أقامها بين الشعراء والكتاب قديمهم وحديثهم مبرزا من خلالها سمات التفوّق الفنّي والأدبي.
1 نذكر منهم محمود سامي البارودي ، وأمير الشعراء أحمد شوقي، وعميد الأدب العربي طه حسين، وصاحب مجلة الرسالة أحمد حسن الزيات، والكاتب والشاعر إبراهيم عبد القادر المازني، والشاعر عبد الرحمن شكري
3 عبد الرحيم البيساني، المعروف بالقاضي الفاضل (526هـ - 596هـ) أحد الأئمة الكتَّاب، ولد بـ"عسقلان" وانتقل إلى الإسكندرية، ثم إلى القاهرة. كان يعمل كاتبا في دواوين الدولة ووزيرًا ومستشارًا للسلطان صلاح الدين لبلاغته وفصاحته، وقد برز في صناعة الإنشاء، وفاق المتقدمين، وله فيه الغرائب مع الإكثار. قال فيه صلاح الدين (لا تظنوا أني فتحت البلاد بالعساكر إنما فتحتها بقلم القاضي الفاضل)، وقال عنه العماد الأصفهانى: "رَبُ القلم والبيان واللسن اللسان، والقريحة الوقادة، والبصيرة النقادة، والبديهة المعجزة". عن الويكيبيديا
10 محمد عبد الغني حسن، وعبد العزيز الدسوقي، روضة المدارس نشأتها واتجاهاتها العلميّة والأدبيّة ، الهيئة المصريّة للكتاب /1975، ص 193

المحاضرة 2
نقد النثر في الوسيلة الأدبيّة للمرصفيّ
المرصفي في كلمات:
إذا كنا نعرف سنة وفاته التي هي 1889 فإنّنا نجهل ميلاده بالضبط ورجّح تاريخ 1815. تربّى المرصفي في أسرة علم فكان والده أستاذا بالأزهر ممّا جعله يحرص على تنشئته تنشئة علميّة وعلى الرغم من فقدانه لبصره وهو ابن الثالثة، فقد عوّضه الله قوة الحافظة سرعة الحفظ؛ فحفظ القرآن وكثيرا من المتون مكّنته من التدريس بالأزهر ثمّ دار العلوم/ الجامعة فيما بعد. تعلّم اللغة الفرنسيّة وأتقنها من خلاله لغة برايل. بل وترجم نصوصا من كتاب الخرافات Les fables لصاحبه "لا فونتان". La Fontaine
يعدّ المرصفيّ أول أستاذ للأدب العربي والنقد في مدرسة دار العلوم العليا، إلى جانب ذلك أصبح الشيخ عضوا في المجلس الأعلى للتعليم المصري، وكان علي مبارك رئيسا لهذا المجلس، وكانت آراء المرصفي وأفكاره البناءة عنصرا داعما لهذا المجلس ونشاطاته. من أهم مؤلّفاته: الوسيلة الأدبيّة إلى العلوم العربيّة
الوسيلة موسوعة فكريّة جمعت علوم اللغة العربيّة تقع في مجلدين، يحتوي الأوّل على 214 صفحة طبع عام 1875، والثاني ـ ويحتوي الثاني على703 صفحة، وطبع عام 1879، ولا توجد طبعات أخرى للكتاب، ويتضمن الكتابان مجموعة من المحاضرات التي ألقاها المرصفيّ في دار العلوم؛ حيث تناول بالدرس أكثر من اثني عشر علمًا، مثل اللغة وأصولها، والنحو، والصرف، والبلاغة، والعروض، والقوافي، والإملاء، وصناعة الترسل، وقرض الشعر، وتاريخ نشأة الفنون وتدوين العلوم، وتاريخ التربية، وتاريخ الكتّاب، والنقد الأدبي. وقد أملى المرصفي كتابه على طلبته وقد نقله إلى القراء الشيخ حسن أبو زيد سلامه، الذي أشرف على طباعته فيما بعد.
يرى النقّاد أنّ المرصفي شائق في محاضراته؛ إذ كان يعرض النصوص الأدبيّة ثم يتعرّض لنقدها، وما يعقده من موازنات بين مجموعة من النصوص القديمة والحديثة، بأسلوب لم يألفه ذوق عصره.
o من أسباب اهتمام القراء بالوسيلة:
- إلقاء المحاضرات على طلبة دار العلوم.
- نشر فصولها في مجلة (روضة المدارس) وهو ما سمح بأن يطّلع عليها عدد كبير من القراء.
- عدّ المرصفي عالما لغوّيا وناقدا أدبيّا يتّكئ على منابع النقد العربي القديم.
o أهميّة المرصفي وكتابه:
اعترف كثير من الرواد[1] بصورة قاطعة أنّ الكتاب قد أسهم في تشكيل مكوناتهم الثقافيّة، وأكّدوا أنّهم تتلمذوا على يديه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. وهو ما يعني أنّ الكتاب قد أسهم بشكل كبير في تغيير الذوق والحاسة الفنية، وكوّن مدرسة أدبية كان لها الفضل على أهل الكلمة والرأي والفكر والإبداع.
يجب أن نشير أن المرصفي وهو يملي محاضراته لم يكن يقصد أنّه يجدّد أصول النقد العربي ولكن على العكس من ذلك تماما؛ فقد كان يريد أن ينفخ فيها ليعيدها إلى ما كانت عليه، ذلك أنّ حركة التجديد في القرن التاسع عشر الميلادي لم تكن قد تهيأت لها الظروف المناسبة للتجديد الذي لا يمكن أن يكون ما لم يكن مرتكزا على قاعدة صلبة ثابتة ينطلق منها. ولذلك نجد المرصفي يقرّ بآراء القدامى كالسكّاكيّ وحازم القرطاجنّيّ وابن رشيق وغيرهم... بل ينقل نصوصا كاملة من القدامى كما فعل مع ابن خلدون في تعريفه للشعر.
o عنوان الكتاب: : الوسيلة الأدبيّة إلى العلوم العربيّة
جاء في لسان العرب: "الوَسِيلَةُ: المَنْزِلة عِنْدَ المَلِك. والوَسِيلة: الدَّرَجة. والوَسِيلة: القُرْبة. ووَسَّلَ فلانٌ إِلى اللَّهِ وَسِيلَةً إِذا عَمِل عَمَلًا تقرَّب بِهِ إِليه. والوَاسِل: الراغِبُ إِلى اللَّهِ؛ قَالَ لَبِيدٌ:
أَرى الناسَ لَا يَدْرونَ مَا قَدْرُ أَمرِهم، ... بَلى كلُّ ذِي رَأْيٍ إِلى اللَّهِ وَاسِلُ
وتَوَسَّلَ إِليه بوَسِيلَةٍ إِذا تقرَّب إِليه بعَمَل. وتَوَسَّلَ إِليه بِكَذَا: تقرَّب إِليه بحُرْمَةِ آصِرةٍ تُعْطفه عَلَيْهِ. والوَسِيلَةُ: الوُصْلة والقُرْبى، وَجَمْعُهَا الوَسَائِل، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أُولئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ. الإسراء 57 والوَسِيلَةُ مَا يُتَقَرَّبُ بِهِ إِلى الغَيْر، وَالْجَمْعُ الوُسُلُ والوَسَائِلُ"[2]. فالحاصل أنّ الوسيلة منزلة أو درجة يصلها المرء، أو هي ما يتقرّب بها الإنسان إلى شيء ما، ومن ثمّ فالوسيلة الأدبيّة هي ما يتقرّب بها الدارس إلى علوم اللغة العربيّة وتوصله إذا تمكّن منها إلى درجة عاليّة. وهو ما كان يريده المرصفيّ من محاضراته/ كتابه
وسيلة يتقرّب بها إلى العلوم العربيّة، وينفذ إلى أعماقها ويسبر أغوارها.
من القضايا التي أثارها المرصفيّ في كتابه:
- الحديث عن اللهجات العامية بطريقة موضوعيّة.
- دراسة علوم جديدة، مثل فقه اللغة.
- التناول النقدي لنصوص شعراء وكتاب معاصرين للمرصفي بطريقة تحليل النصوص وتذوّقها.
- محاولة تحليل الأدب بصورة تقترب ممّا يعرف الآن باسم التحليل النفسي كمنهج سياقيّ للأدب أو المنهج النفسي في النقد الأدبي.
- أوّل من أرسى قواعد المنهج التاريخي في الدرس الأدبيّ ومن خلال هذا المنهج قسّم الشعراء إلى طبقات ثلاث:
- طبقة الجاهليين والإسلاميين من المهلهل إلى بشار بن برد.
- طبقة المحدثين الحارصين على موافقة العرب المجتهدين في سلوك طرائقهم، من أبي نواس إلى قبيل القاضي الفاضل[3].
- طبقة الشعراء الذين غلب عليهم استعمال النكات والإفراط في مراعاة البديع من القاضي الفاضل إلى عصر المرصفيّ.
وقد درس خصائص كل طبقة ممّا جعله يضع اللبنة الأولى للمنهج التاريخي في دراسة الأدب
وهو كتاب ينهج فيه طريقة الآمالي لأبي علي القالي والكامل للمبرّد وغيرهما... ويختلف عنهم في أنّه لا يقتصر على الأدب وروايته ولكنّه يضيف إلى ذلك "جميع علوم اللغة العربيّة من نحو وصرف وعروض وفصاحة وبيان وبديع ومعان ثمّ الأدب بفرعيه الشعر والنثر، متحدّثا عن كلّ فنّ على حدة ولكن على طريقة الاستطراد والتداعي المعروفة في كب الآمالي القديمة"[4] وهو ما يدلّ على مدى تمكّنه من التراث اللغوي والأدبي إذ كثيرا ما كان يستشهد بمحفوظاته الضخمة التي تدلّ على ذوق "سليم في الاختيار كما ينمّ حديثه عن علوم اللغة عن فقه وتعمّق وحافظة جبّارة فضلا عن حديثه عن رائدي البعث الأدبي في عصره محمود سامي البارودي الشاعر وعبد الله فكري الناثر وإيراده عددا كبيرا من قصائد البارودي الشعريّة ومقطوعات عبد الله فكري النثريّة والموازنة بينهما وبين شعر القدماء ونثرهم".[5] وهذه في حدّ ذاتها إضافة جديدة لما كان سائدا في عصره. مستفيدا من كلّ ما قرأه سابقا من علوم اللغة وموازنة الآمديّ.
يعدّ الكتاب الأوّل من الوشيلة كأنّه مدخل للأفكار التي يريد أن يتعرّض لها في الكتاب الثاني، فقد ذكر فيه "القواعد وتعريفات العلوم وبعض المسائل النظريّة التي تتصل بالأدب ولا تدخل في مباحثه واهتمّ أيضا بالتأصيل النظريّ للمعارف الإنسانيّة"[6] فنراه يعرف اللغة والصرف والاشتقاق والنحو والمعاني والبيان والبديع والعروض والقوافي والإنشاء والنظم والكتابة والتاريخ فهو مثلا يعرّف البيان بقوله: "علم يبيّن المجاز والكناية"[7] ويعرّف النظم بقوله: "ويقال له القريض وقرض الشعر هو علم يبيّن كيفيّة النظم في الأغراض المختلفة من حكم ووعظ ونسيب ومدح وعتب وتعطّف وتأديب وغير ذلك"[8] وقد ختم الكتاب الأوّل بحديثه عن أحسن الطرائق لتحصيل علوم العربيّة واختلافها بحسب العصور وفيها تظهر "ثقافة المرصفي الغزيرة، ومواهبه، وتفتّحه على الجديد، وإحساسه بأنّ الحياة دائمة التجدّد في كلّ شيء"[9]
الكتاب الثاني سياحة عميقة في علوم البلاغة الثلاثة هدفها مواجهة النصّ الأدبيّ وتذوّقه، ويكون المرصفي بكتابه/ المجلّد الثاني قد "أسهم في تغيير الذوق والحساسيّة الفنيّة وكوّن مدرسة أدبيّة لها الفضل في بعث النقد العربي الحديث، بل لقد ألهم الروّاد في مجال الإبداع الفنّي فلا شكّ أنّه من مفجّري طاقة البارودي الشعريّة ومن الذين سدّدوا طريقه"[10] وبحديثه عن مواجهة النصّ وقراءته وتذوّقه وبيان ما فيه - وهي مشكلة تواجه النقد الحديث – يكون قد أسّس للنقد الجمالي الذي يكون هو أحد روّاده. ويبدأ هذا المجلّد بالمقصد الثالث في فنون البلاغة حيث تحدّث فيه عن فنّ البيان فتناول المجاز والاستعارة والكناية ثم تعرّض لعلم المعاني فتناول الجملة وأجزاءها ثم تفرّغ لعلم البديع.
يلاحظ أنّه أسهب كثيرا في موضوعات البديع حتّى أنّه تجاوز مئة صفحة (51 – 168)مع أنّها محسّنات لفظيّة "تحذلق علماء البديع المتأخّرون في سردها والتفريق بينها، مع أنّها كلّها لا تخرج عن كونها محسّنات لفظيّة عميقة كانت من الأسباب الرئيسيّة في تحويل الأدب العربيّ كلّه إلى زخارف خاويّة من كلّ معنى عميق أو إحساس صادق، وكأنّما الأدب قد استحال إلى مجرّد زخارف"[11] وهو ما يبيّن موقف الدكتور محمد مندور من المحسّنات البديعيّة وكأنّه يعترض عليه فعل ذلك إذ أسهب في الحديث عنها بينما ترك علمي البيان والمعاني الذي يراهما أرفع شأنا من فنون البديع الذي هو أشبه بالفنون التشكيليّة أو ما يسمّونه بفن الأرابيسك التي تقوم على زخرفة الظاهر بينما علم البيان هو "دراسة أصليّة لوسائل أكيدة من وسائل التصوير الأدبيّ، بل الخلق الجماليّ عن طريق التشبيهات والاستعارات والمجازات أي الصور الأدبيّة التي تميّز الأدب كفنّ تصويريّ عن غيره من أنواع الكتابة التقريريّة، وعلى حين يعتبر علم المعاني دراسة للتراكيب اللغويّة وطرائق الأداء والتلوين الفكريّ والعاطفيّ ممّا يقابل علمي الأسلوب Stylistique والتراكيبSyntaxe في اللغات الأوربيّة"[12].
o المبادئ التي يقوم عليها الشعر عند المرصفي:
يرى المرصفي أنّه حتى تتمكّن الملكة من صاحبها لا بدّ من توافر ثلاث مراحل:
1 مطالعة الجيّد من الإنتاج والحفظ.
2 الدربة الطويلة والمستمرّة
3 نسيان المحفوظ لتمحى رسومه الحرفيّة
لا تنمو ملكة الشعر في راي المرصفي إلا بكثرة بحفظ مطالعة الجيّد من الشعر، وهي الطريقة الوحيدة منذ العصور القديمة التي يتمّ من خلالها تحصيل ملكة الشعر. وبعد حصول الملكة لا بدّ من أن يتدرّب طويلا على نظم الشعر والإكثار منه حتى تستحكم الملكة منه. وهو رأي رآه من قبل الناقد الفرنسيّ الكبير جورج دي هامل Georges Duhamel[13] الذي تحدّث في كتابه "دفاعا عن الأدب " عن الروائيّ أونوريه دي بالزاك Honoré de Balzac[14] أنّه قد سوّد مئات الصفحات قبل أن يعثر على بلزاك. ثمّ بعد ذلك عليه أن ينسى ذلك المحفوظ حتّى تنسى رسومه الحرفيّة وتبقى الفكرة فقط يستطيع أن يعبّر عنها بطريقة أخرى فيها جدّة.
أسلوب المرصفيّ في الوسيلة علميّ حيث كان قادرا "على الفحص والتحقيق والتدقيق والتأمّل العميق والوصول بعد ذلك إلى نتائج محدّدة واضحة لا تضيع في خضمّ الاستطرادات والنقول وهو ما يسهّل عمليّة التمييز بين آرائه وآراء من يستشهد بأشعارهم وأقوالهم، ثمّ كان حريصا على نسبة النقول التي ينقلها إلى أصحابها، وهذه مسألة علميّة لم تكن معروفة في دنيا التأليف حينذاك"[15] وهو ما يؤكّد نظرة المرصفي الثاقبة وتميّزه عن أقرانه بما اكتسبه من ثقافة عاليّة ناجمة عن مطالعات عميقة للتراث الأدبي والنقدي.
يمكن القول أخيرا إنّ الشيخ المرصفي كان من روّاد البعث الأدبي المعاصر ومن بناته الأصليّين من خلال ما كتبه عن صناعتي الشعر والنثر وطريقة تعلّمهما والموازنات التي أقامها بين الشعراء والكتاب قديمهم وحديثهم مبرزا من خلالها سمات التفوّق الفنّي والأدبي.
1 نذكر منهم محمود سامي البارودي ، وأمير الشعراء أحمد شوقي، وعميد الأدب العربي طه حسين، وصاحب مجلة الرسالة أحمد حسن الزيات، والكاتب والشاعر إبراهيم عبد القادر المازني، والشاعر عبد الرحمن شكري
3 عبد الرحيم البيساني، المعروف بالقاضي الفاضل (526هـ - 596هـ) أحد الأئمة الكتَّاب، ولد بـ"عسقلان" وانتقل إلى الإسكندرية، ثم إلى القاهرة. كان يعمل كاتبا في دواوين الدولة ووزيرًا ومستشارًا للسلطان صلاح الدين لبلاغته وفصاحته، وقد برز في صناعة الإنشاء، وفاق المتقدمين، وله فيه الغرائب مع الإكثار. قال فيه صلاح الدين (لا تظنوا أني فتحت البلاد بالعساكر إنما فتحتها بقلم القاضي الفاضل)، وقال عنه العماد الأصفهانى: "رَبُ القلم والبيان واللسن اللسان، والقريحة الوقادة، والبصيرة النقادة، والبديهة المعجزة". عن الويكيبيديا
10 محمد عبد الغني حسن، وعبد العزيز الدسوقي، روضة المدارس نشأتها واتجاهاتها العلميّة والأدبيّة ، الهيئة المصريّة للكتاب /1975، ص 193
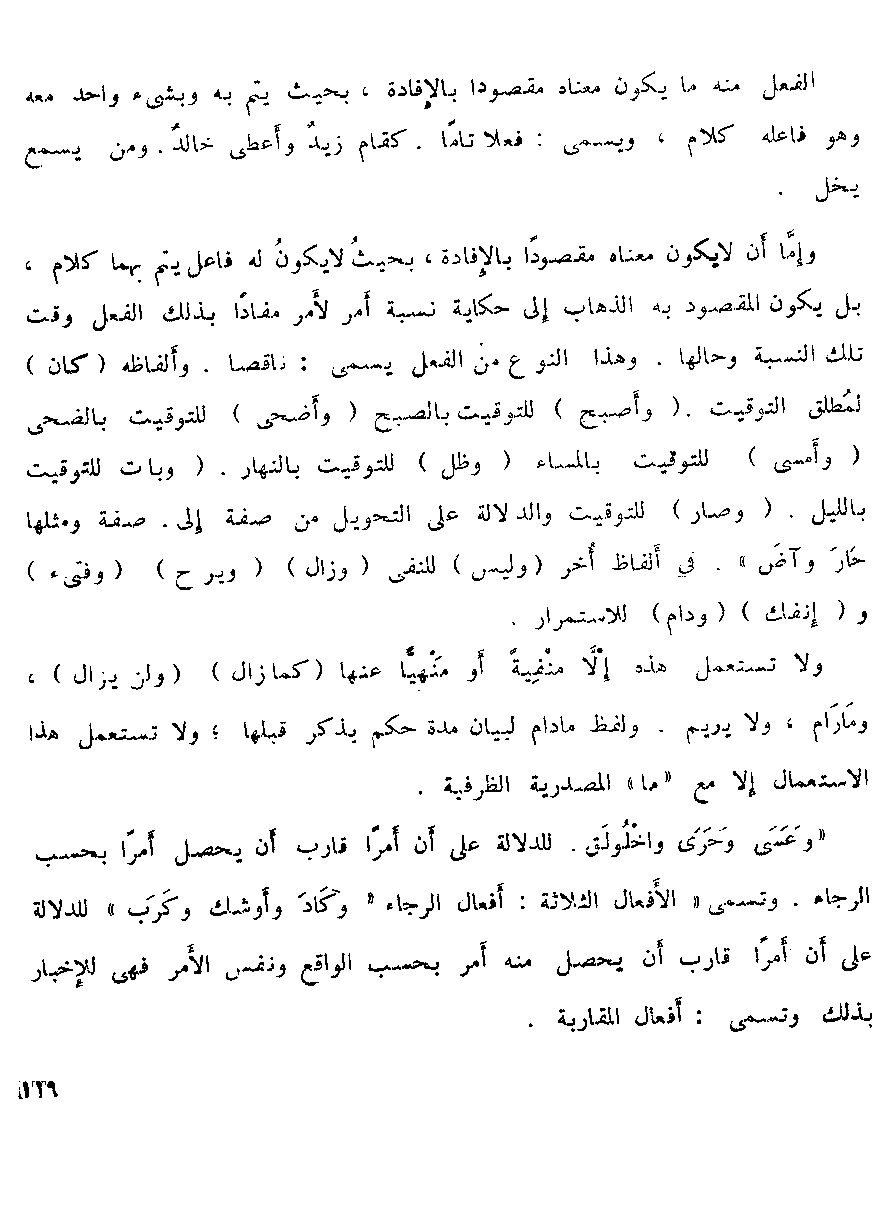
نقد النثر الحديث والمعاصر
المحاضرة الأولى
توطئة:
ماذا نقصد بالنثر؟ هل هو كلّ ما ليس شعرا، أي: "كلّ كلام لا ينظمه وزن ولا قافيّة"[1] أي كلّ كلام يقوله الناس. وهل كلام الناس في الشارع والبيت والسوق نثر؟ هل مؤرّخو الأدب يقفون على هذه النوع من الكلام ويعدّونه نثرا؟
لا شكّ أنّ هذا النوع من الكلام الذي يكون بين الناس في حاجاتهم اليوميّة قد تكون له أهميّة في الدراسات اللسانيّة وعلم النفس والانتروبولوجيا وعلم الاجتماع ... غير أنّ الباحث لا يجد هذا النوع مسجّلا في تاريخ الأدب، ذلك أنّ مؤرّخي الأدب لا يعنون به لأنّهم لا يقفون إلا على ما يرونه أدبا، أمّا ما يقوله الناس عادة في حياتهم اليوميّة وحاجاتهم العاديّة المبتذلة فليس من الأدب في شيء لذلك لا يسجّلونه، ومن ثمّ فهم يقفون على ما نسمّيه النثر الفنّي وهو "مظهر من مظاهر الجمال، وفيه قصدٌ إلى التأثير في النفس، في أيّ ناحيّة من أنحائها"[2] وهذا يعني أنّ اللغة تتدخّل في تحديد النثر، فيجب أن تكون لغته أدبيّة تثير النفس والشعور. وهذا يعني أنّ له خصائص ومميّزات تبعده عن لغة الشارع.
فالنثر شكل آخر للأدب غير الشعر وهو يشكّل معه الوجه الثاني لعملة الأدب. ولكلّ ميزاته التي تميّزه عن الآخر، فالشعر له شكله وموسيقاه حدّده بن جعفر بقوله: "قول موزون مقفى يدل على معنى"[3] ولم يترك الكلام على امتداده ولكنّه شرح معاني ألفاظه بقوله: "وقولنا: موزون: يفصله ممّا ليس بموزون، إذ كان من القول موزون وغير موزون. وقولنا: مقفّى: فصل بين ماله من الكلام الموزون قواف، وبين ما لا قوافي له ولا مقاطع. وقولنا: يدل على معنىً: يفصل ما جرى من القول على قافية ووزن مع دلالة على معنى مما جرى على ذلك من غير دلالة على معنى"[4]. فغير الموزون عندهم لا يسمى شعرا.
وإذا كان قدامة حدّد الشعر في كتابه نقد الشعر فإنّه في كتابه نقد النثر لم يحدّد النثر وإنّما تحدّث فيه عن البيان مبيّنا أن الجاحظ ذكر في كتابه "أخبارا منتخلة وخطبا منتخبة ولم يأت فيه بوصف البيان، ولا أتي على أقسامه في هذا اللسان وكان عندما وقفت عليه غير مستحقّ لهذا الاسم الذي نسب إليه"[5] فهو كتاب إذاً في أقسام البلاغة وليس في نقد النثر. ولا نجد حديثا عن النثر إلا في قوله "... بنية الشعر إنما هو التسجيع والتقفية، فكلما كان الشعر أكثر اشتمالاً عليه كان أدخل له في باب الشعر وأخرج له عن مذهب النثر"[6]. ليبيّن أن الفرق بين النثر والشعر إنّما هي الوزن والقافيّة في الثاني وانعدامها في الأول. وهو رأي متواتر عند الباحثين القدامى فقد ذكر ابن خلدون الفرق نفسه فقال: "اعلم أنّ لسان العرب وكلامهم على فنّين؛ في الشعر المنظوم وهو الكلام الموزون المقفّى ومعناه الذي تكون أوزانه كلّها على رويّ واحد وهو القافيّة. وفي النثر وهو الكلام غير الموزون"[7]
غير أن الدراسات الحديثة لا تكتفي بهذا الفرق الشكلي في التمييز بينهما إذ ترى فيه تمييزا كمّيّا لا نوعيّا وتذهب إلى التفريق بينهما في أمور أخرى منها:
"النثر اطّراد وتتابع لأفكار ما، في حين أنّ هذا الاطراد ليس ضروريّا في الشعر.
النثر يطمح إلى أن ينقل فكرة محدّدة ولذلك يطمح إلى أن يكون واضحا أمّا الشعر فيطمح إلى أن ينقل شعورا أو تجربة أو رؤيا ولذلك فإن أسلوبه غامض بطبيعته.
النثر وصفي تقريريّ ذو غاية خارجيّة معيّنة ومجدّدة بينما غاية الشعر هي في نفسه، فمعناه يتجدّد دائما يتجدّد قارئه"[8]. وأدونيس يرى هذا الفرق لأنّه يرى الشعر بمنظور آخر يبعده عن الحادثة لأنّ الشعر عنده يتجّه نحو المستقبل، ومن ثمّ يرفض أن يكون الشعر شعر وقائع أو شعرا واقعيّا بالمعنى الشائع للكلمة لأنّه في هذه الحالة يقترب من النثر العادي، لأنّه يستخدم قاموسا لدلالاته السابقة، وغير ذلك من الآراء التي تنادي بها المدرسة الجديدة للشعر.*
النثر "هو الكلام غير الموزون" وله فنون منه "السجع الذي يؤتى به قطعا ويلتزم في كلّ كلمتين منه قافيّة واحدة تسمّى سجعا ومنه المرسل وهو الذي يطلق فيه الكلام أطلاقا ولا يقطع أجزاء بل يرسل إرسالا من غير تقييد بقافيّة ولا غيرها.
يرى مؤرّخو الأدب أنّ الشعر أقدم وأسبق إلى الوجود من النثر لأنّه "متّصل بالحسّ والشعور والخيال" وهي ملكات أثبت العلم أنها تنشأ مع الفرد والجماعة. وأما النثر "فهو لغة العقل ومظهر من مظاهر التفكير" والعقل عادة ما يتأخّر عن الإنسان ولا ينال منه حظّا إلا بعد حين من الدهر، وتاريخ الأدب يثبت أنّ الأمم تأخذ بحظها من الشعر قبل كلّ شيء، وتنفق من حياتها عصورًا طوالًا يتطوّر فيها الشعر ويستحيل وهي تجهل النثر جهلًا تامٍّا"[9].فالنثر بذلك أحدث من الشعر لأنّه مرتبط بملكة التفكير أي العقل وشيوع ظاهرة الكتابة إذ العقل يفكّر ويبدع والكتابة تتقيّد تفكيره وتسجّلها وتعلنها للناس.
ويجب أن نشير أن الشعر يحتاج إلى العقل ولكن اعتماد اللغة الخاصّة والوزن والقافيّة والخيال تضيّق من انطلاقه وتقيّده فيتخلّص منها وهنا يظهر النثر كفن لا هو شعر ولا هو لغة التخاطب اليومي وتدوّن به الفنون الأخرى على اختلاف مشاربها.
وكما للشعر فنون ومذاهب في الكلام فكذلك للنثر فنون ومذاهب منها "السجع الذي يؤتى به قطعا ويلتزم في كلّ كلمتين منه قافيّة واحدة تسمّى سجعا ومنه المرسل وهو الذي يطلق فيه الكلام إطلاقا ولا يقطع أجواء بل يرسل إرسالا من غير تقييد بقافية ولا غيرها. ويستعمل في الخطب والدعاء وترغيب الجمهور وترهيبهم." وهو ما يعني أنّ النثر ليس مجرد الكلام الذي يكون بين المتخاطبين ولكن الذي يخضع لجملة من المقاييس والاعتبارات الفنيّة التي تحوّله من الكلام العادي إلى الكلام الفنّي.
والنثر قديما لم يزد على كونه مجموعة فنون ذكرها قدامة في نقد النثر حيث قال: "وليس يخلو المنثور من أن يكون خطابة أو ترسّلا أو احتجاجا أو حديثا"[10] ثمّ يبيّن وجوه استعمال كل فنّ من هذه الفنون. غير أنّ هناك فننا أخرى ظهرت في العصر الحديث منها المقالة والقصّة والرواية والمسرحيّة والخاطرة وغيرها من الفنون النثريّة التي لم تكن معروفة سابقا أنتجتها الاتصالات بالآداب الأجنبيّة.
وإذا كان النثر متأخرا عن الشعر لأنه يعتمد أساسا على العقل فإنّ عمليّة نقد النثر متأخرة أيضا عن النثر الفنّي لاعتمادها على المنطق والعقل والموضوعيّة. وقد بدأ ذلك مع عصر النهضة حيث الانفتاح على الآخر والعودة إلى المنابع الأصليّة للنثر العربي بعدما سادت فترة الركود بعد غزو المغول للعالم الإسلامي وسيطرة الأعاجم على البلاد العربيّة. فمع النهضة بدأت الأقلام تعود إلى كتابات الجاحظ والجرجاني مبتعدة عن كتابات عصر الضعف ومحاولة إيجاد لغة جديدة لا هي جاحظيّة ولا هي عاميّة مما ساعد على إنتاج نثر فنّي ملائم للعصر خال من أي تقعّر لغويّ.
[1] طه حسين، في الأدب الجاهلي، مؤسّسة هنداوي للتعليم والثقافة، ص 285
[2] م ن، ص ن
[3] قدامة بن جعفر، نقد الشعر، مطبعة الجوائب – قسطنطينية، ط1/1302، ص 3
[4] م ن، ص 3.
[5] قدامة بن جعفر، نقد النثر – أقسام البيان- تح: طه حسين وعبد الحميد العبادي، مطبعة دار الكتب المصريّة – القاهرة، 1933، ص 10
[6] م ن، ص17
[7] عبد الرحمن ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، كتاب إلكتروني، ص 270
[8] أدونيس، زمن الشعر، دار العودة - بيروت ، ط2/1978، ص 16
* للتوسّع في ذلك ينظر كتاب أدونيس زمن الشعر ص 10 وما بعدها
[9] طه حسينن في الأدب الجاهلي، ص 286
[10] قدامة بن جعفر، نقد الشعر، مطبعة الجوائب – قسطنطينية، ط1/1302، ص 82
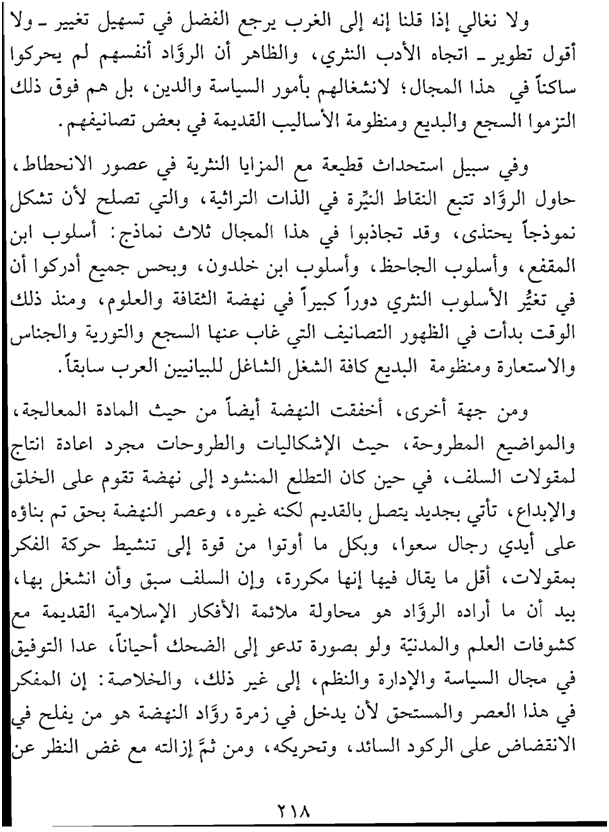
نقد النثر الحديث والمعاصر
المحاضرة الأولى
توطئة:
ماذا نقصد بالنثر؟ هل هو كلّ ما ليس شعرا، أي: "كلّ كلام لا ينظمه وزن ولا قافيّة"[1] أي كلّ كلام يقوله الناس. وهل كلام الناس في الشارع والبيت والسوق نثر؟ هل مؤرّخو الأدب يقفون على هذه النوع من الكلام ويعدّونه نثرا؟
لا شكّ أنّ هذا النوع من الكلام الذي يكون بين الناس في حاجاتهم اليوميّة قد تكون له أهميّة في الدراسات اللسانيّة وعلم النفس والانتروبولوجيا وعلم الاجتماع ... غير أنّ الباحث لا يجد هذا النوع مسجّلا في تاريخ الأدب، ذلك أنّ مؤرّخي الأدب لا يعنون به لأنّهم لا يقفون إلا على ما يرونه أدبا، أمّا ما يقوله الناس عادة في حياتهم اليوميّة وحاجاتهم العاديّة المبتذلة فليس من الأدب في شيء لذلك لا يسجّلونه، ومن ثمّ فهم يقفون على ما نسمّيه النثر الفنّي وهو "مظهر من مظاهر الجمال، وفيه قصدٌ إلى التأثير في النفس، في أيّ ناحيّة من أنحائها"[2] وهذا يعني أنّ اللغة تتدخّل في تحديد النثر، فيجب أن تكون لغته أدبيّة تثير النفس والشعور. وهذا يعني أنّ له خصائص ومميّزات تبعده عن لغة الشارع.
فالنثر شكل آخر للأدب غير الشعر وهو يشكّل معه الوجه الثاني لعملة الأدب. ولكلّ ميزاته التي تميّزه عن الآخر، فالشعر له شكله وموسيقاه حدّده بن جعفر بقوله: "قول موزون مقفى يدل على معنى"[3] ولم يترك الكلام على امتداده ولكنّه شرح معاني ألفاظه بقوله: "وقولنا: موزون: يفصله ممّا ليس بموزون، إذ كان من القول موزون وغير موزون. وقولنا: مقفّى: فصل بين ماله من الكلام الموزون قواف، وبين ما لا قوافي له ولا مقاطع. وقولنا: يدل على معنىً: يفصل ما جرى من القول على قافية ووزن مع دلالة على معنى مما جرى على ذلك من غير دلالة على معنى"[4]. فغير الموزون عندهم لا يسمى شعرا.
وإذا كان قدامة حدّد الشعر في كتابه نقد الشعر فإنّه في كتابه نقد النثر لم يحدّد النثر وإنّما تحدّث فيه عن البيان مبيّنا أن الجاحظ ذكر في كتابه "أخبارا منتخلة وخطبا منتخبة ولم يأت فيه بوصف البيان، ولا أتي على أقسامه في هذا اللسان وكان عندما وقفت عليه غير مستحقّ لهذا الاسم الذي نسب إليه"[5] فهو كتاب إذاً في أقسام البلاغة وليس في نقد النثر. ولا نجد حديثا عن النثر إلا في قوله "... بنية الشعر إنما هو التسجيع والتقفية، فكلما كان الشعر أكثر اشتمالاً عليه كان أدخل له في باب الشعر وأخرج له عن مذهب النثر"[6]. ليبيّن أن الفرق بين النثر والشعر إنّما هي الوزن والقافيّة في الثاني وانعدامها في الأول. وهو رأي متواتر عند الباحثين القدامى فقد ذكر ابن خلدون الفرق نفسه فقال: "اعلم أنّ لسان العرب وكلامهم على فنّين؛ في الشعر المنظوم وهو الكلام الموزون المقفّى ومعناه الذي تكون أوزانه كلّها على رويّ واحد وهو القافيّة. وفي النثر وهو الكلام غير الموزون"[7]
غير أن الدراسات الحديثة لا تكتفي بهذا الفرق الشكلي في التمييز بينهما إذ ترى فيه تمييزا كمّيّا لا نوعيّا وتذهب إلى التفريق بينهما في أمور أخرى منها:
"النثر اطّراد وتتابع لأفكار ما، في حين أنّ هذا الاطراد ليس ضروريّا في الشعر.
النثر يطمح إلى أن ينقل فكرة محدّدة ولذلك يطمح إلى أن يكون واضحا أمّا الشعر فيطمح إلى أن ينقل شعورا أو تجربة أو رؤيا ولذلك فإن أسلوبه غامض بطبيعته.
النثر وصفي تقريريّ ذو غاية خارجيّة معيّنة ومجدّدة بينما غاية الشعر هي في نفسه، فمعناه يتجدّد دائما يتجدّد قارئه"[8]. وأدونيس يرى هذا الفرق لأنّه يرى الشعر بمنظور آخر يبعده عن الحادثة لأنّ الشعر عنده يتجّه نحو المستقبل، ومن ثمّ يرفض أن يكون الشعر شعر وقائع أو شعرا واقعيّا بالمعنى الشائع للكلمة لأنّه في هذه الحالة يقترب من النثر العادي، لأنّه يستخدم قاموسا لدلالاته السابقة، وغير ذلك من الآراء التي تنادي بها المدرسة الجديدة للشعر.*
النثر "هو الكلام غير الموزون" وله فنون منه "السجع الذي يؤتى به قطعا ويلتزم في كلّ كلمتين منه قافيّة واحدة تسمّى سجعا ومنه المرسل وهو الذي يطلق فيه الكلام أطلاقا ولا يقطع أجزاء بل يرسل إرسالا من غير تقييد بقافيّة ولا غيرها.
يرى مؤرّخو الأدب أنّ الشعر أقدم وأسبق إلى الوجود من النثر لأنّه "متّصل بالحسّ والشعور والخيال" وهي ملكات أثبت العلم أنها تنشأ مع الفرد والجماعة. وأما النثر "فهو لغة العقل ومظهر من مظاهر التفكير" والعقل عادة ما يتأخّر عن الإنسان ولا ينال منه حظّا إلا بعد حين من الدهر، وتاريخ الأدب يثبت أنّ الأمم تأخذ بحظها من الشعر قبل كلّ شيء، وتنفق من حياتها عصورًا طوالًا يتطوّر فيها الشعر ويستحيل وهي تجهل النثر جهلًا تامٍّا"[9].فالنثر بذلك أحدث من الشعر لأنّه مرتبط بملكة التفكير أي العقل وشيوع ظاهرة الكتابة إذ العقل يفكّر ويبدع والكتابة تتقيّد تفكيره وتسجّلها وتعلنها للناس.
ويجب أن نشير أن الشعر يحتاج إلى العقل ولكن اعتماد اللغة الخاصّة والوزن والقافيّة والخيال تضيّق من انطلاقه وتقيّده فيتخلّص منها وهنا يظهر النثر كفن لا هو شعر ولا هو لغة التخاطب اليومي وتدوّن به الفنون الأخرى على اختلاف مشاربها.
وكما للشعر فنون ومذاهب في الكلام فكذلك للنثر فنون ومذاهب منها "السجع الذي يؤتى به قطعا ويلتزم في كلّ كلمتين منه قافيّة واحدة تسمّى سجعا ومنه المرسل وهو الذي يطلق فيه الكلام إطلاقا ولا يقطع أجواء بل يرسل إرسالا من غير تقييد بقافية ولا غيرها. ويستعمل في الخطب والدعاء وترغيب الجمهور وترهيبهم." وهو ما يعني أنّ النثر ليس مجرد الكلام الذي يكون بين المتخاطبين ولكن الذي يخضع لجملة من المقاييس والاعتبارات الفنيّة التي تحوّله من الكلام العادي إلى الكلام الفنّي.
والنثر قديما لم يزد على كونه مجموعة فنون ذكرها قدامة في نقد النثر حيث قال: "وليس يخلو المنثور من أن يكون خطابة أو ترسّلا أو احتجاجا أو حديثا"[10] ثمّ يبيّن وجوه استعمال كل فنّ من هذه الفنون. غير أنّ هناك فننا أخرى ظهرت في العصر الحديث منها المقالة والقصّة والرواية والمسرحيّة والخاطرة وغيرها من الفنون النثريّة التي لم تكن معروفة سابقا أنتجتها الاتصالات بالآداب الأجنبيّة.
وإذا كان النثر متأخرا عن الشعر لأنه يعتمد أساسا على العقل فإنّ عمليّة نقد النثر متأخرة أيضا عن النثر الفنّي لاعتمادها على المنطق والعقل والموضوعيّة. وقد بدأ ذلك مع عصر النهضة حيث الانفتاح على الآخر والعودة إلى المنابع الأصليّة للنثر العربي بعدما سادت فترة الركود بعد غزو المغول للعالم الإسلامي وسيطرة الأعاجم على البلاد العربيّة. فمع النهضة بدأت الأقلام تعود إلى كتابات الجاحظ والجرجاني مبتعدة عن كتابات عصر الضعف ومحاولة إيجاد لغة جديدة لا هي جاحظيّة ولا هي عاميّة مما ساعد على إنتاج نثر فنّي ملائم للعصر خال من أي تقعّر لغويّ.
[1] طه حسين، في الأدب الجاهلي، مؤسّسة هنداوي للتعليم والثقافة، ص 285
[2] م ن، ص ن
[3] قدامة بن جعفر، نقد الشعر، مطبعة الجوائب – قسطنطينية، ط1/1302، ص 3
[4] م ن، ص 3.
[5] قدامة بن جعفر، نقد النثر – أقسام البيان- تح: طه حسين وعبد الحميد العبادي، مطبعة دار الكتب المصريّة – القاهرة، 1933، ص 10
[6] م ن، ص17
[7] عبد الرحمن ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، كتاب إلكتروني، ص 270
[8] أدونيس، زمن الشعر، دار العودة - بيروت ، ط2/1978، ص 16
* للتوسّع في ذلك ينظر كتاب أدونيس زمن الشعر ص 10 وما بعدها
[9] طه حسينن في الأدب الجاهلي، ص 286